أسرة البلاغ
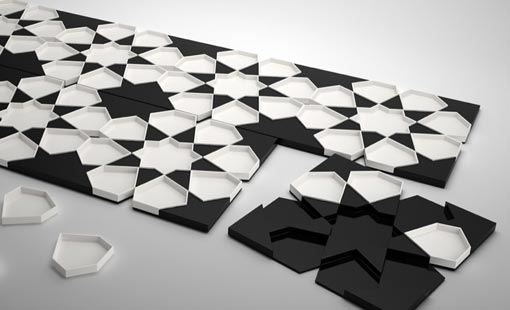
لمعالجة قضية الرقابة على الفنون الإسلامية فيجب أن نفرق أوّلاً بين مفهومي الرقابة، والنقد..
فالمراقبة نظر عن بعد فهي من ثم مشاهدة للخطوط العامة أو التحركات الأساسية، من أين بدأت؟ وكيف سارت؟ وماذا حدث لها في سيرها؟ وكيف تخطت عقباتها وتغلبت عليها؟ وأين تسير في حركاتها؟ وهل تتجه إلى ما هو أقوم؟ أم أن اتجاهها يوردها موارد التهلكة والبوار؟ وسواء نظر الإنسان إلى ظواهر الاجتماع عن بُعد، أو نظر إلى ذاته عن بُعد بأن وقف منها موقفاً موضوعياً فراقب نتيجة أعمالها وطبيعة مسيرتها.. سواء مراقبة الغير أم مراقبة الذات فإنّ المراقبة لا تكون إلا بوجود بعد اجتماعي – إن أجيز هذا التعبير – أو بعد سيكولوجي، أو وجود الاثنين معاً عند التقييم والتقدير.
وأمر ثان، هو أنّ المراقبة تعني الالتزام بالتقييم، والالتزام بالتغيير أو التصحيح على أقل تقدير.. وعلى هذا فالمراقب حكم وحاكم في نفس الآن.
أمّا النقد فالصفة الغالبة عليه أنّه تقدير للباطن، وفحص لدقائقه وعناصر تكوينه. فهو على هذا نظر عن قرب، أو هو نفاذ إلى داخل البناء لدراسة تكوينه ومضمونه، ومدى اتساق عناصر التكوين مع بعضها، ومدى خدمة ذلك التكوين للهدف الخاص الذي أنشىء البناء من أجله وخدمته للهدف العام أو الروح العامة التي تسري في كيان المجتمع وتسمه بسماتها المميزة..
وغاية النقد أن يبصر وينبه ويهدي لما يجب أن يكون، بغير أن يُلزِم أن تكون لديه السلطة القادرة على التغيير.
ومن مفهومي كلّ من المراقبة والنقد نخرج بسمات مشتركة بينهما هي:
أوّلاً: أنّ كلاً منهما يفحص ويحلل.
ثانياً: أنّ كلاً منهما يقيم ويزن.
ثالثاً: أنّ كلاً منهما نتيجة للوزن والتقييم يتخذ موقف القبول، أو موقف الرفض من الأثر الذي عرض له.
رابعاً: أنّ كلاً منهما يهدف إلى ما هو أقوم.
أما ما يختلف عنده كلّ من الرقابة والنقد فهو أنّ المراقبة مشاهدة وفحص للخطوط العامة أو الاتجاه العام، على حين أنّ النقد يُعنى في المقام الأوّل بتحليل الكيان الداخلي للعمل واستخراج مدلول كلّ عنصر فيه.. والشيء الثاني أنّ المراقبة تتخذ صبغة المسؤولية الرسمية أو الالتزام الرسمي الذي يملك سلطة التغيير والتبديل والإلغاء.. أما النقد فحسبه التحليل والمقابلة والتقييم. ولذلك يصح أن نقول: إنّ الرقيب ملزم لنفسه وملزم لغيره على حين أنّ الناقد ملتزم بأصول الفن الذي يتعرض له ويعالجه.
وعلى هذه التفرقة بين الرقابة والنقد نتناول الفنون الإسلامية.. ومن الناس من قد يتساءل: أوليس في القول "بفنون إسلامية"، أنّ الإسلام ينفر من بعض الفنون أو ينفر من جانب من الحياة قد تكون له فيه متعة أو قد تكون فيه سعادة للناس وإعانة لهم على ما يعانون؟
ونقول رداً على هذا التساؤل وما قد يكون على غراره: إنّ الإسلام لا يحرم على الإنسان أن يستمتع بمتع الحياة الدنيا ولا يحجر عليه بالقمع والكبح والإرهاب.. ولكنه يفتح آفاق الحياة أمام بصره وفكره فيسعى فيها كيف يشاء اجتناء لما تشتهيه نفسه، ولما يجد فيه موطن لذة ومغنم وسعادة. وذلك بضوابط تحيي الحياة في نفسه، وتحيي الحياة في مجتمعه وأمته وإنسانيته.
وتتركز الضوابط في قوله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (القصص/ 77)، إنّ هذه الآية الكريمة أو القاعدة العامة بأركانها وأسسها هي المبدأ الذي تقوم عليه الحياة، والمذهب الذي ينبغي الدعوة إليه والعمل من أجله.
ولكي نتخذ من هذه الآية الكريمة دستوراً نستهديه سواء الإبداع الفني أو الرقابة على الفنون.. لكي نستهديها دستورا نحتكم إليه عند تقدير الفنون فإنّه يجب أن نضع في اعتبارنا أربعة أمور:
أوّلاً: سلامة البناء النفسي والفكري والديني للفرد.
ثانياً: سلامة البناء الاجتماعي في عقيدته وتقاليده وفكره وتآصر وحداته..
ثالثاً: قدرة الطرفين متآصرين ومتعاطفين على النهوض برسالة الإسلام لإسعاد البشرية جمعاء..
رابعاً: أن يكون الفن لله وفي سبيل الله..
وفي هذه القواعد الأربع المتكاملة يمكننا تحديد مقاييس الرقابة على الفنون الإسلامية..
· المقياس الأوّل: أن يكون الفن دعوة للحياة؛ يقول سبحانه: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل/ 125)، وربما قيل بأن معنى أن يكون الأثر الفني: "حكمة"، وداعياً إلى "الحكمة"، وأنّه ينبغي أن يقاس بمقياس "الحكمة"، هو أننا نقيس الأثر الفني بمقياس أخلاقي تحكمي، أو بمقياس أخلاقي ضيق عقيم؛ فيه حجر على الفكر والشعور أكثر من أيّ شيء آخر.
ولكننا نبادر فنقول إنّ ما نريده من أن يكون الفن "حكمة" أو تعبيراً عن "حكمة"، هو أن يتجلى فيه صدق الرؤية وعمقها، وأصالة التعبير الإبداعي الذي يعطي بلمحة منه أو بلمحات منه الانطباع الحي للتآلف العضوي لمقوماته. سواء تآلفت في لحن أو صورة، أو تمثال أو قصيدة؛ وذلك كي يعطي الأثر الفني أملاً في الحياة وثقة في الغد. وما هو أكثر، يعطي الوعي يقظة والضمير حركة مستنيرة والإرادة تصميماً على العمل وإصراراً على الحياة.. فإذا استطاع الفنان أن يظهر هذه المعاني أو يجسد هذه المعاني، أو على أقل تقدير يترك أثره الفني فعله في الوجدان والخيال، فقد استقام الأثر الفني وما أريد منه واستقام كلّ شيء مفهوم الحكمة..
ويمكننا أن نضيف أنّه إذا كان يجب أن يكون الفن دعوة إلى رؤية حكيمة فذلك أنّ الرؤية الحكيمة التي يقتضيها المقياس الإسلامي في مراقبة الفنون لا تحجر على الذات كما يتوهم المتوهمون الذين يظنون أنّ الرؤية الحكيمة لا تتيح للذات الانطلاق التلقائي الحر. ذلك الانطلاق الذي تستخرج به الذات ذخر مكنونها من الأحلام والإرهاصات، وذوب عبقريتها المحلقة في أجواء فوق أجواء من الإبداع الفني المنقطع النظير.
وبذلك ينجو الفن من التحكم الأخلاقي الذي يحكم على نضرة الفن بالإعجاف والذبول لأنّه فوق إخماده لحيوية الانطلاق الذي يحيي المضمون فإنّه يجعل الفنان أسير النماذج التي رضيت عنها أخلاق الجمود.. أما أنّ مبدعات كبار الفنانين والعباقرة ضرورية كنماذج للتمثل والسير على هداها.. وكآيات على مدى ما يمكن أن يبلغه الكمال الإنساني في عالم الفنون فتلك ضرورة حيوية سواء بالنسبة إلى معرفة الدلالة الحضارية والتاريخية لتطور الفن أم بالنسبة إلى تعلم الفن ذاته.. ذلك لأنّ الفنان لا يخلق من فراغ والفن لا يأتي من عدم.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ الفن حياة وحياة الفن تاريخ وأطوار.. والتاريخ وجود متصل، ومن هنا تصبح آثار الخالدين من الفنانين آيات استهداء واستلهام وتمثل.
· المقياس الثاني: ويدعو إلى أن يكون الفن إذكاء لمشاعر الناس وأفكارهم، وإصلاحاً لأحوالهم ومنافعهم؛ يقول سبحانه: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ) (الرعد/ 17)...
ولقد يقال إنّ هذا المقياس نفعي، فهو من ثم يقدر الفن أو الأثر الفني بما يأتي به من أموال أو بما يحققه من أرباح. وذلك يؤدي إلى التدهور في أصالة الإبداع الفني فتتجه الفنون إلى السوقية والابتذال ومخاطبة غرائز الجماهير وأهوائهم.
ونبادر فنقول: إنّ المنفعة مطلوبة، والسعي إلى طلب الرزق فريضة، والتمتع بالحياة واجب لا يُبَغَّضُ فيه.. فمتع الحياة من العمران والاجتماع؛ يقول سبحانه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (الأعراف/ 32)..
فالضابط إذن أنّ المعيار القويم هو الإيمان بالله.. والإيمان بالله جمال ووضوح ورصانة.. أما قوله سبحانه: (وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ) (الرعد/ 17)، فهو يمثل أحكم الضوابط وأبعدها أثراً في إثراء حياة الناس، وإثراء الفنون.. فالفنون ينبغي أن تكون لنفع الناس لا لنفع طبقة أو عصابة. فليس ها هنا شح حقود أو أنانية؛ ولكنه التفتح والحب للناس أجمعين. وهذا يؤكد عنصر الشمول الذي يجب أن تتضمنه الفنون، أي يجب أن توحي بما يؤكد ما بين البشرية من وحدة الأصل والمصير. وبذلك تزكو عواطف الناس وتتأصل إرادتهم، فلا تقهرهم المحن فتفقدهم الثقة فيمن حولهم وما حولهم وربما أفقدتهم الإيمان بخالقهم وتلك هي المحنة الكبرى..
· المقياس الثالث: هو مقياس الالتزام؛ يقول سبحانه: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (التوبة/ 105).
ومقياس الالتزام مقياس متهم عند الكثرة الغالبة من المفكرين. فهم يرون فيه نوعاً من الإرغام على اتباع مذهب معيّن من مذاهب السياسة أو الاجتماع. وسواء أرغم الفنان على الالتزام أو ألزم هو نفسه اعتقاداً واقتناعاً فإنّ ذلك من شأنه أن يجعل نظرته قاصرة عن أن تتشوق إلى ما بعد الحدود التي رسمت له أو إلى ما وراء الأفق الذي لا يجوز له أن يتخطاه.. وفي ذلك إضعاف لملكة الخلق وإضلال للبصيرة الفنية عن أن ترى الرؤية الصادقة فتسجل رؤيتها عملاً فينا رائعاً خالداً.
أما الإسلام الحنيف فإنّه يقدم الآية الكريمة مقياساً للالتزام ومعياراً تقاس به أصالة الفنون. فهو يحيط العمل بضوابط من الإيجابية المطلقة، وذلك بأن جعل الإنسان مسؤولاً عمن حوله مسؤولية كونية – إن أجيز هذا التعبير – أيّ ملتزماً بأداء عمله على أكمل ما يكون وأصل ما يكون، وفي حدود وسعه بطبيعة الحال.
وهذه المسؤولية الكونية، أو هذا الالتزام الكوني شمولي بكلِّ معاني الشمول: فالإنسان مسؤول أمام الله قبل كلّ شيء، ومسؤول أمام قائد الأُمّة ورائدها، ومسؤول أمام المؤمنين، أيّّ المجتمع بأسره. فإذا بلغت مسؤولية الفنان هذه الدرجة فإنّ آثاره تصبح كفاء هذه المسؤولية، أيّ تصبح خالدة يتأثر بها الفرد والجماعة والبشرية.. إنّ الالتزام هنا يحرر الفن من قوالب الجمود..
ويحرر الفكر من إسار التقاليد..
ويحرر العواطف من سَوْرة الشهوات المدمرة..
فلننظر إلى الفنون في ضوء هذا الالتزام القرآني، ولنقوِّم كلا منها على أساسه، فإن استقام وإياه فأحيا مشاعر الإيمان وإرادة العمل في الإنسان فكأنما قد أحيا الناس جميعاً.. وإن كان على غير ذلك فقد وجبت المراجعة والمحاسبة.
وإذا سأل سائل فقال: إذا جاءت المقاييس الثلاثة بهذه الصفات، فهل معنى ذلك أنّ الرقابة على الفنون ليس لها حدود؟
إنّ هذه المقاييس القرآنية هي بطبيعتها التي تضع حدود الرقابة على الفنون.. ومع ذلك فإنّنا نأتي من القرآن الكريم بما يجب أن تكون عليه حدود الرقابة. فالقاعدة العامة للحدود هي قوله سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...) (البقرة/ 143).
وفرق بين الحدود والقيود، فالحدود ضوابط تنظم للفنان عمله وتقيه سقطات الجموح أو الجمود.. أما القيود فإنها تحول دون انطلاق الفكر والخيال إلى الخلق والإبداع فتحبسها في قوالب متحجرة فارغة من الحس والحياة.
فحدود المقاييس ينبغي أن تكون وسطا، فإذا كان الفن ينادي بالعقل والتعقل فيجب أن تكون للصبغة العقلية حدود.. فتكون العاطفة متكاملة مع العقل فلا يطغى أحدهما على الآخر، ولا يستأثر أحدهما بإخراج العمل الفني إلى واقع المجتمع. ذلك لأنّ العقل إذا طغى انقلب العمل الفني إلى قضايا منطقية تصرف العين أو الأذن عن متابعة المشاهد.. وتزهم النفس عن التمتع بجمال الحياة.. والفنون جميعاً تعبير عن الإحساس بالحياة وبجمال الحياة.
وكذلك العاطفة إذا طغت على العقل أصبح العمل الفني دعوة جامحة إلى التطلع في أخذ أسباب الحياة. فلكلّ امرىء أن يترك نفسه لتلقائية الغرائز فيفعل ما يشاء كيف يشاء. بل إنّ في طغيان العاطفة تضييع لمعالم الحقيقة وسط الجموح الانفعالي الذي يلف ملامح الأثر الفني بضبابه، وذلك هو الغموض الذي يحير ويشكك.. بل ويفقد الأثر الفني وجوده وحدوده ووجهته ولو في الخيال.
وإذا كانت الفنون في عمومها دعوة إلى الحبّ والتآلف والتعارف.. وإذا كانت أيضاً دعوة إلى العمل والنضال، فينبغي من ثم ألا تنقلب دعوة التآلف إلى مصانعة، ولا دعوة الصفح الجميل إلى نفاق. ولكن على الفنون أن تكون تمثيلاً للإحساس بالجمال..
والجمال حقّ وخير.. فهو لا يعرف الممالأة أو المداراة. وهذا من الحدود التي يجب على كلِّ فنان أن يلتزم بها؛ يقول سبحانه: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلا) (النساء/ 142)..
نأتي بعد هذا إلى من يكون له حقّ الرقابة على الفنون الإسلامية حتى لا تنحرف، فإذا انحرفت كان عليه أن يعيدها إلى الطريق السليم.. فالرقابة هي أوّلاً وقبل كلّ شيء للدولة. فهي الحفيظة على سلامة الأُمّة، وهي الرقيبة على كلِّ ما يتهددها أن يجور عليها.. ومن ثمّ كان على الدولة أن تعين هيئات لها السلطة في مراقبة الفنون، ولها القدرة على مراقبة الفنون، وأن تكون ملتزمة بقوله تبارك وتعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104)، فالرقابة الفنية الإسلامية دعوة إلى الخير، والدعوة إلى الخير في عالم الفنون تقدير للجمال وإشادة به وتشجيع عليه وحرص على إزكائه وإنمائه.
والأمر بالمعروف توجيهٌ وإرشاد، كما أنّه دعوة إلى الإطلاع على الفنون عند الأُمم المتقدمة فنقتبس منها ما هو نافع لأُمتنا ونطوع ما يتفق وأخلاقنا وتقاليدنا ومستقبلنا..
أما النهي عن المنكر فله عدة سبل: فقد يأتي تحذيراً مما يستهوي الأذواق ولا يُعْقب غير الفساد والانحلال. وقد يأتي حذفاً وإلغاء لما قد يؤدي إلى الانحراف أو إشاعة الفحشاء والمنكر.. فالرقابة على الفنون واجب الدولة عليها أن توليه غاية اهتمامها. على أن يكون إلى جانب هذه الرقابة العامة رقابة خاصة. ونقصد بذلك رقابة النقاد على الفنون – أو رقابة الصحافة على الفنون – فالناقد رقيب وزيادة، فعليه في نقده أن يكون يقظاً، داعياً لتبيان نواحي الضعف والتهافت، وأن يكون صريحاً جادا، وألا يخشى في الحقِّ لوماً أو تهديداً، حسبه قوله تبارك وتعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (آل عمران/ 173).
المصدر: مجلة هدي الإسلام/ العدد 36 لسنة 1992م
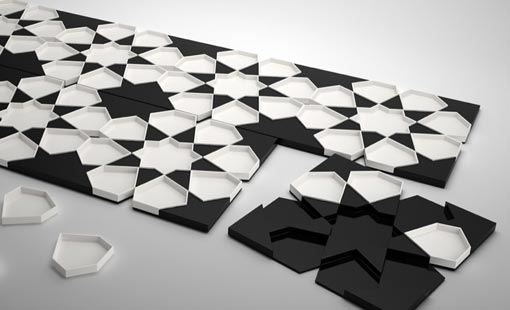
ارسال التعليق