- ٦ كانون ثاني/يناير ٢٠٢٥ | ٦ رجب ١٤٤٦ هـ
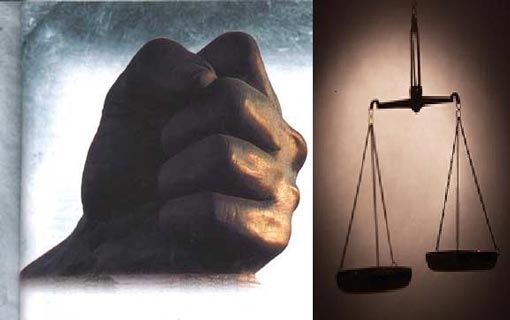
كان من نتائج تقدم العلم الحديث (الرياضيات والفيزياء خاصة) في القرنين السادس عشر والسابع عشر أن تبلورت في القرن الثامن عشر، مع العالم الإنكليزي الشهير إسحق نيوتن خاصة، النظرة الآلية للطبيعة التي زعزعت كامل النظام المعرفي السائد، وخلخلت سائر التصورات العلمية والفلسفية السابقة، مما كانت نتيجته قيام ما عرف بـ"عصر التنوير والعقل". لقد صاغ نيوتن كما هو معروف نظرية الجاذبية العامة في صورة قانون رياضي (عقلي) جعل من نظام الطبيعة ونظام العقل مظهرين لحقيقة واحدة، فأصبح مفهوم "الطبيعة" يعني لا الأشياء الجامدة المعروضة أمام الإنسان، بل أصبح يعني "النظام العقلي للأشياء بوصفه نظاماً كلياً يشمل كل ما في الطبيعة بما في ذلك الإنسان نفسه". ونتيجة لذلك، صار الناس يطابقون بين ما هو طبيعي وما هو عقلي: بمعنى أنّ ما في الطبيعة يخضع لنظام دقيقة خضوع أجزاء الآلة للآلة ككل، مما يجعل تلك الأجزاء قابلة لإدراك العقل وفهمه. وبالمثل: كل ما يبدو معقولاً، أي مبرراً في نظر العقل، فهو طبيعي، أي أنّه متسق أو لابدّ من أن يكون متسقاً مع الطبيعة.
من هنا بدأت فكرة القانون الطبيعي تغتني وتكتسي دلالات جديدة واضحة. وفي هذا الإطار ألّف الفيلسوف الإنكليزي كريستيان وولف كتاباً يحمل عنواناً ذا دلالة خاصة: القانون الطبيعي مدروساً حسب المنهج العلمي (عام 1754)، والمقصود بالمنهج العلمي هنا هو المنهج الاستدلالي الرياضي. يقوم هذا المنهج على النظر إلى القانون الطبيعي على أنّه جزء من الطبيعة الإنسانية المغروزة في كل فرد بشري. وعلى أساسه يتم التمييز بين الحق والواجب. ذلك لأنّ فكرة "ما هو شرعي – قانوني – وما هو لازم يجب القيام به"، أي فكرة الحق والواجب، هي فكرة من صميم الجوهر الإنساني نفسه، ومن هنا كانت هذه الفكرة عالمية، كلية كونية. يقول: "إنّ الحق الطبيعي، أعني الفطري في الإنسان، هو حق مشتق من إلزام طبيعي، بحيث إنّه متى فرضنا هذا الإلزام وجب وجود هذا الحق. وبما أنّ الطبيعة، أو جوهر الإنسان، تفرض بعض الواجبات والإلزامات، فهي بالنتيجة تقرر بعض الحقوق. وبما أنّ الطبيعة، أو جوهر الإنسان، شيء مشترك بين جميع الناس، فإن كل قانون طبيعي هو قانون كلي كوني، لم يكتسبه الإنسان، بل يحمله معه مع مجيئه إلى هذا العالم".
في إطار هذا المنهج "العلمي" كتب المفكر الفرنسي المعروف البارون دور مونتسكيو كتابه الشهير "روح القوانين". يقول في مستهل هذا الكتاب: "إنّ الكائنات الخاصة المزوّدة بالعقل والذكاء يمكن أن تتوفر لها قوانين سنّتها لنفسها، ولكن يمكن أيضاً أن تكون لديها قوانين لم تسنّها هي. وقبل أن توجد كائنات عاقلة، كان من الممكن أن توجد هذه الكائنات، وكان يمكن أن تقوم بينها علاقات، وبالتالي قوانين ممكنة. وإذاً فقبل أن تكون هناك قوانين موضوعة (وضعية) كانت هناك علاقات عادلة ممكنة. وإذاً فقبل أن تكون هناك قوانين موضوعة (وضعية) كانت هناك علاقات عادلة ممكنة. أما القول بأنّه لم يكن هناك شيء عادل أو غير عادل إلا ما يأمر به أو تحدّده القوانين الوضعية، فهو كالقول بأنّه قبل رسم الدائرة لم تكن شعاعاتها متساوية. يجب إذاً الاعتراف بوجود قوانين عادلة سابقة للقانون الوضعي الذي يقررها".
هكذا أصبحت مهمة العقل هي الكشف عن الجانب الطبيعي، أي المعقول، في كل ميدان، وبالتالي الإلقاء بكل ما هو غير طبيعي عرض الحائط، أي بجميع الزيادات والإضافات التي تراكمت عبر العصور نتيجة تصورات ترجع إلى التقليد والاعتقاد في أمور من دون استعمال العقل.
وإذا كان القانون العلمي الذي يجمع شتات الظواهر في علاقة كلية ثابتة مطردة هو القانون المعبّر عن حقيقة الطبيعة، فإنّ هناك في الحياة الإنسانية ما هو بمثابة طبيعتها وقانونها الكليين: إنّه الطبيعة الإنسانية، وأيضاً المثل العليا التي تتصف بـ"الكونية"، والتي يجدها الإنسان في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، لدى الشعوب المتحضرة كما لدى الشعوب البدائية. ومن هنا تلك الظاهرة التي عرفتها الثقافة الأوروبية يومئذ، ظاهرة نقد المجتمع الأوروبي بواسطة رسائل "فارسية" و"صينية" وما يكتب عن "الرجل البدائي". كل ذلك لإبراز قيم "كونية" تحدّد المثل الأعلى الذي يجب السعي إلى تحقيقه.
ذلك أنّه، كما أدى تقدم البحث في العلوم الرياضية والطبيعية إلى المطابقة بين ما هو عقلي وما هو طبيعي، فلقد أدى اتساع اطلاع مفكري أوروبا على حياة المجتمعات المختلفة (الشرقية والبدائية) إلى المطابقة بين ما هو طبيعي وما هو بدائي أولي – فطري – في الحياة البشرية، مما كانت نتيجته قيام تصورات لـ"عصر ذهبي للبشرية كان الناس فيه على دين طبيعي قبلوه لأنّه معقول في جوهره" – دين الفطرة بالتعبير الإسلامي – لكن القائمين على السلطتين الدينية والسياسية من "الكهنة المتآمرين والملوك في العصور التالية أفسدوه وانتهوا به إلى الخرافات من أجل منفعتهم". إنها "حالة الطبيعة" التي سبق أن تعرفنا عليها قبل كفرضية غير مؤسسة التأسيس الكافي، والتي سنرى الآن كيف أعيد تأسيسها من أجل اعتمادها في تفسير كونية حقوق الإنسان، وبكيفية خاصة الحق في الحرية والمساواة.
فعلاً، افترض فلاسفة الفكر السياسي الحديث في أوروبا القرن السابع عشر والثامن عشر وجود "حالة طبيعية" للإنسان، فبعضهم جعلها واقعاً بشرياً سابقاً للتنظيم الاجتماعي والسلطة السياسية، بينما أراد منها آخرون التعبير فقط عما يمكن أن يكون عليه الإنسان إذا هو لم يخضع لفعل التربية ولا لسلطة قانون أو حكومة. وإذا كان جميع فلاسفة الفكر السياسي الحديث في أوروبا قد وظفوا بصورة أو بأخرى فرضية "حالة الطبيعة" هذه، فإنّ الفيلسوف الإنكليزي جون لوك (1632-1704) هو الذي عمل أكثر من غيره على بناء هذه الفرضية بالصورة التي تجعلها قابلة لأن تكون مرجعية تؤسس فكرة "الحرية والمساواة"، وهي الفكرة التي ستتأسس عليها كافة حقوق الإنسان. يقول: "لكي نفهم السلطة السياسية فهماً صحيحاً ونستنتجها من أصلها، يجب علينا أن نتحرى الحالة الطبيعية التي وجد عليها جميع الأفراد، وهي حالة الحرية الكاملة في تنظيم أفعالهم والتصرف بأشخاصهم وممتلكاتهم بما يظنون أنّه ملائم لهم، ضمن قيود قانون الطبيعة، دون أن يستأذنوا إنساناً أو يعتمدوا على إرادته، وهي أيضاً حالة المساواة حيث السلطة والتشريع متقابلان لا يأخذ الواحد أكثر من الآخر، إذ ليس هناك حقيقة أكثر بداهة من أنّ المخلوقات المنتمية إلى النوع والرتبة نفسها، المتمتعة كلها بالمنافع نفسها التي تمنحها الطبيعة وباستخدام الملكات نفسها، يجب أيضاً أن يتساوى بعضها مع بعضها الآخر".
"حالة الطبيعة" إذاً هي حالة الحرية والمساواة التي يكون عليها الناس قبل أن تقوم فيهم سلطة تحدّ من حقهم في ممارستهما – أعني الحرية والمساواة – غير "قانون الطبيعة" نفسه، القانون الذي يرمي إلى "حفظ الجنس البشري وضمان سلامته، والذي يؤول أمر تنفيذه إلى كل إنسان".
ولم تكن فرضية "حالة الطبيعة" مجرد فكرة تعتمد على الوهم والخيال، بل كانت تستند إلى التصور الجديد الذي شيّده العلم الحديث عن "الطبيعة" كما رأينا. وهكذا فالمقصود بـ"الطبيعة" في عبارة "حالة الطبيعة" ليس الأشياء الجامدة المنفصلة عن الإنسان، بل المقصود، كما قلنا هو: "كامل النظام الفعلي للأشياء بما في ذلك الإنسان الذي هو جزء منه"، الإنسان الذي هو من عمل الطبيعة: موجود فيها وخاضع لقوانينها".
والناس في هذا سواسية وأحرار، بعضهم إزاء بعض، لأنّ حق الإنسان في الحرِّية والمساواة هو حق طبيعي له من عمل الطبيعة. ومن هنا تلك المطابقة بين مفهوم "حقوق الإنسان" وعبارة "الحقوق الطبيعية": حقوق الإنسان هي حقوق طبيعية له. وواضح أنّ الإحالة إلى "الطبيعة" هنا معناها تأسيس تلك الحقوق على مرجعية سابقة على كل مرجعية: فالطبيعة سابقة على كل ثقافة وحضارة، وعلى كل مجتمع ودولة، وبالتالي فهي مرجعية "كونية" عالمية، كلية مطلقة، والحقوق التي تأسس عليها هي حقوق "كونية" عالمية، كلية مطلقة كذلك.
"حالة الطبيعة" لا تعني الفوضى، بل هي حالة يسري فيها، كما قلنا، قانون الطبيعة. ولما كان من المحتمل جدّاً أن تقوم نزاعات بين الناس عند ممارسة كل منهم حقه الطبيعي، فلقد صار من الطبيعي كذلك أن يعملوا على تأويل وتطبيق "قانون الطبيعة" بالصورة التي تضمن حقوق كل فرد، وهذا لا يتأتى إلا بـ"إقامة ضرب من الاتحاد بينهم يحمي شخص كل واحد منهم ويمكّنه من ممارسة حقوقه، ويسمح لكل منهم، وهو متحد مع الكل، بأنّ لا يخض إلا لنفسه، وبالتالي يبقى متمتعاً بالحرِّية التي كانت له من قبل".
المصدر: كتاب في نقد الحاجة إلى الإصلاح
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق