- ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٤ | ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ
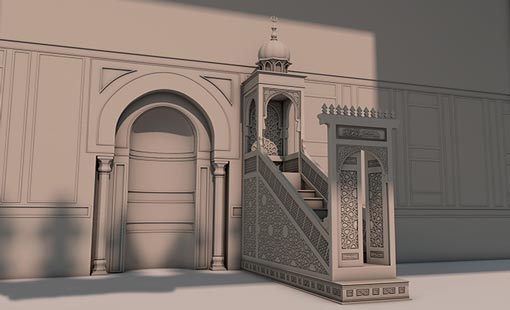
◄ما اتفقت كلمة مثقفي الأُمّة في عصرنا على شيء مثل اتفاقها على أنّ الأُمّة الإسلامية في سائر شعوبها، وفي مقدمتها الشعب العربي، تعيش أزمة فكرية، تتجلى في شكل غياب ثقافي، وتخلف علمي، وكسوف حضاري، وتتجسد في عجز الخطاب الفكري المعاصر عن إيصال مضمون الخطاب الإسلامي السليم ومحتواه، قرآناً وسنة وشريعة وأخلاقاً، وإن اختلفوا في تحديد الأسباب ووسائل العلاج.
- المشروع الإسلامي
إنّ الخطاب الذي انبثق من المشروع الإسلامي، قد انصرف في جزء كبير منه إلى الكفاح والتعبئة له بحكم ظروف الصراع المرير بين الأُمّة وأعدائها الناتج عن احتلال أهم وأكثر ديار المسلمين في القرن الميلادي الماضي وأوائل هذا القرن، وتحويل بعضها إلى مناطق حماية ونفوذ، وبعضها الآخر إلى أسواق ومجالات حيوية، فأدى ذلك إلى الانشغال بحماية الأُمّة وتوجيه اهتماماتها وطاقاتها نحو قضيتين أساسيتين: حفظ العقيدة من ناحية، وتعبئة الأُمّة للمواجهة السياسية وربّما الجهادية أو العسكرية في بعض المواقع أو بعض الأحيان، من ناحية أخرى، ثمّ إذا بقي في الطاقات فضلة وجهت باتجاه القضايا الفقهية، لإعادة تقديمها وشرحها واختصارها ومقارنتها بالقضايا القانونية للفكر الغربي.
أمّا معالجة الأزمة الفكرية فلم يعطها الخطاب الإسلامي - إلى وقت قريب - ما تستحقه من العناية والاهتمام، وما تستلزمه من الدرس والتحليل.
أ) توجيه الاهتمام لحفظ العقيدة:
والملاحظ أنّ حظاً كبيراً من الجهود صرف في الدعوة لحفظ العقيدة الإسلامية، ربما لاعتقاد البعض أنّ مفاهيم الإسلام الصحيح - في عقول وقلوب أبناء الأُمّة - لم ينلها تغيير كبير مادامت لم تنكر شهادة الحقّ بعد، وهذا صحيح إلى حدٍّ كبير، لكنّه لا يقبل على إطلاقه. ذلك أنّ المفاهيم قد أصابها تحريف وتغيير كبيران مع عمارة القلوب بالإيمان بالله تعالى وبرسوله، فإذا استصحبنا هذا وأحسنا التعامل معه، فإنّه يشكّل الإمكان المعرفي الذي نسعى لبنائه بشكل منهجي صحيح؛ لتحويل العقيدة إلى قاعدة فكرية ومعرفية.
هناك وَهمٌ بأنّ حقن الأُمّة بشحنات من الحماس والخُطب، ومزيد من التوثب الروحي، والتذكير بالأمجاد المشرقة للواقع التاريخي كفيل بانطلاق الأُمّة من جديد نحو حياة إسلامية راغدة، وحضارة إسلامية جديدة، ووحدة إسلامية شاملة، دون بناء عالم فكري ومفاهيمي ومعرفي وثقافي صحيح، يوجّه حركة الأُمّة، ويرسي قواعد سيرها ونهجها؛ وفي هذا الكثير من المجازفة، وفقدان الرؤية الصائبة، والاكتفاء بالإحساس بالمشكلة عن التفكّر في إدراك الحل لها، ويشهد على ذلك الواقع المتردي الذي تعيشه وتعاني منه الأُمّة.
عندما تجمّدت بحوث العقيدة ضمن قوالب ومساحات ومقولات جامدة، بخاصّة عند متأخري الكلاميين، وحُوصرت مفاهيمها بحدودهم المنطقية وأساليبهم الجدالية داخل الصف الإسلامي، غاب عنها الفكر الذي هو ثمرة لتحويل العقيدة إلى عمل، وتنزيلها على واقع يعيد صياغتها مع المحافظة على الأصول، ويمدها بروح التجديد ومواكبة العصر ويجعل منها إطار رؤية كلّية، ومنهجاً ونموذجاً معرفياً كلّياً.
ب) تعبئة الأُمّة للمواجهة السياسية:
لقد كان لصدمة الإحساس بالضعف أمام الجيوش الاستعمارية الغازية وحضارته الوافدة وقع على أغلب فصائل الأُمّة شطرها إلى فريقين:
- فريق المبهورين بالثقافة الغازية، الداعين إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية حسب الأنماط الغربية، الناعتين للإسلام بالعجز عن مواكبة الحداثة والمعاصرة، يستوي في الانتماء له القائلون بالتخلي التام عن الإسلام وتراثه، والمنادون بالتعايش مع الدِّين مع صياغة البناء أو المجتمع المدني بعيداً عن شريعته.
- وفريق يرى سبب التخلف في البُعد عن الإسلام وقيمه، وهذا الفريق منقسم ما بين حاصر لمرض الأُمّة في تشويه العقيدة، وضعف الإيمان والانشغال بالترف، وفريق آخر يراه في توقف حركة الجهاد والاجتهاد العقلي منذ القرن الرابع الهجري.
فكان الفريق الأوّل يرى البدء بالإصلاح التربوي والاجتماعي والسياسي حتى ولو أدّى ذلك إلى العنف السياسي وهدم البُنى التحتية للأُمّة، ويرى الثاني ضرورة البدء بمقاومة الفكر الأجنبي، وإحياء الثقافة الإسلامية، وتنقية العقيدة من الشوائب، والرجوع إلى الكتاب والسّنة، ثم استيعاب الحضارة الحديثة بعد تنقيتها من الشوائب وتكييفها مع أحكام الإسلام وقيمه. واستمر طوال أزيد من قرن صراع مرير ومتناقض شديد بين الفريقين، فما يعتبره أحد الفريقين مصدراً للتقدّم والرقي، يراه الآخر مصدراً للعمالة والتبعية والانحطاط، وما يراه فريقٌ حلاً، يراه الآخر مشكلة وأزمة.
من هنا كان اهتمام مشروع الإصلاح الإسلامي خطاباً وبرنامجاً، معنياً بالمدخل السياسي والتركيز على حشد الجهود لتعبئة الجماهير الإسلامية للمواجهات السياسية، إمّا لكسب سبق في التعبئة السياسية الشعبية، أو رد فعل لما يصدر عن الخصوم من ازدراء وتشويه للإسلام وشريعته، مما نتج عن إرجاع الأزمة إلى وجود أفراد غير ملتزمين على هرم السلطة، أو حصر أسبابها في بقاء جماعات ومؤسسات رسمية أو غير رسمية في مجالات التأثير، أو غير ذلك من المظاهر التي استفحلت، حتى ذهب البعض إلى أنّ سبب الداء الحقيقي جهات خارجية، وحصر آخرون علّة العلل في بقاء السلطان، الذي لا يطبق الأحكام، وذهب فريق إلى أنّ أصل المرض وجود قوى عظمى معادية أو غير ذلك من التفاسير السريعة، والتحاليل المرتجلة، التي تجعل من النتائج أسباباً، ومن المسكّنات علاجاً، ناسين أو متناسين أنّ أصل الداء علل كامنة في فكر الأُمّة، وأنّ مكمن هذا الوباء في النفس، والعقل المسلم وفي فكره المتقاعس عن ممارسة التغيير طبقاً للسنة الربانية الثابتة (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد/ 11).
ج) من عوائق الإصلاح:
واستيعاباً لما تقدّم، فإنّ الخطاب الإسلامي المعاصر قد يحتاج للخروج من الأزمة إلى أن يعمل على توضيح أمور عدة نوجز أهمها فيما يلي:
- الخلط بين العقيدة والفكر:
لن نضيف جديداً إذا ذكرنا أنّ سبب الخلط الحاصل في أذهان البعض بين العقيدة والفكر هو عدم التمييز بين مصدريهما. فمعلوم أنّ العقيدة وحي إلهي محدد الأركان، ثابت الحدود والمعالم، والفكر اجتهادٌ بشري محض، يحتمل الخطأ والصواب، له حقيقته ومنطلقاته وأدواته ووسائله وبديهي أنّ الفكر البشري هو الثمرة لتعامل العقل مع الوحي وتنزيله على الواقع، وتقويم الواقع به بصياغة ملائمة، وحلول مناسبة، وأبنية عقلية ومعرفية سليمة.
- الاعتقاد بأنّ المعرفة لا دين لها:
يُضاف إلى أصحاب الخلط بين العقيدة والفكر، أولئك الذين يتوهمون أنّ المعرفة لا دين لها، ويرون أنّها تتدين بدين حاملها ولو لم ينتجها، فتتبعه في دينه ومذهبه بقطع النظر عن فلسفتها ومنطلقاتها وأهدافها وغاياتها. وذلك لقصور في إدراك بنية المعرفة ومقوماتها وشروط إنتاجها وصناعتها، مما جعل هؤلاء يتصوّرون أنّ الإنسان إذا كان مسلم العقيدة، مستقيم التوجه، فإنّ أية ثقافة أو معرفة يكتسبها، سوف تنقلب لديه بشكل طبيعي أو آليّ معرفة إسلامية وثقافة إسلامية، ذلك أنّها بدخوله معه المسجد للصلاة، ومصاحبتها له حين الحج أو العمرة، ستسلم، سواء خرجت تلك المعرفة من رأس داروين، أو فرويد أو ماركس أو ديوارنت أو جون ديوي أو دور كايم، أو انبثقت عن ذهن الغزالي أو ابن رشد أو ابن خلدون، أو سواهم.
وهذا غاية الخلط والتداخل، فالمعرفة ثمرة لفلسفة وعقيدة ورؤية كلّية ونظرية تنتجها ولا تنفك عنها، وهي في النهاية المولد الثقافي للأُمّة. ولكلّ عقيدة تصوّرها للكون والحياة والإنسان، ولكلّ معرفة منطلقاتها وأهدافها. واستعارة معرفة من ثقافة أخرى، كتعليق الثمار على أشجارها، فلا يمكن للأشجار أن تروي الثمار، ولا للثمار أن تتنفس من خلال الأشجار.►
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق