أ. نبيل علي صالح*
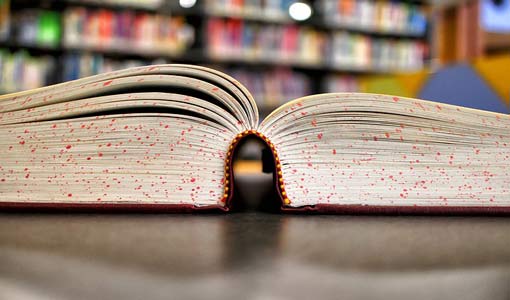
◄لدى مراجعتي المتواصلة لكثير من كتب التراث، تطالعني باستمرار أحاديث غير قليلة تتناول أهمية النقد، وضرورة حساب الذات والنفس قبل حساب الواقع والحياة.. ومن هذه الأحاديث ما يقوله الإمام الرضا (ع): "ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم.. فإن حسناً استزاد الله، وإنْ عمل سيئاً استغفر لله، وتاب عليه".
إنّ دراسة هذا النص تفيدنا في تحديد رؤية الإمام (ع) لمسألة النقد، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تعميق الروح النقدية على المستويين: الذاتي الداخلي، والموضوعي الخارجي، في مفاصل اجتماعنا السياسي والمدني الحالي، وإعلاء كلمة العقل، وترسيخ مبدأ العقلانية الواقعية، والعمل على إيجاد تربته المناسبة. وذلك من أجل الكشف عن حقيقة أزمات الواقع المعاصر الذي نحياه ونعايشه بإيجابياته وسلبياته، وتحليل ظروفه وأحواله المختلفة، وأخذ العبر والدروس منه، بحيث يقودنا ذلك إلى ضرورة تجديد الروح الإسلامية والعقل الإسلامي، والانفتاح على العالم والحياة، واعتماد مبدأ الاجتهاد والتجديد والروح العلمية المجردة، والرؤية الموضوعية للذات والإنسان وللعالم بشكل دائم.
وقد يظن البعض أن هذا الحديث محصور بالجانب العاطفي الوجداني (النفسي) من حياة الإنسان؛ لأنّه يحضه على ضرورة التزام النقد والمحاسبة على صعيده الذاتي فقط، ولكن المسألة هنا هي أنّ ذاتية الإنسان غير منفصلة بالمطلق عن خارجيته، إذ إننا نجد أن حركة الإنسان وفعالياته ونشاطاته مرهونة ومعلولة بمعظمها لطبيعة تصوره ومفهومه عن الحياة والوجود كله، مما يعني أن وعي الإنسان وإدراكه لواقعه الخارجي هو في الإجمال وعي وإدراك وتكيف لذاته ومفاهيمه وأفكاره مع الواقع الخارجي.. وإلّا فإنّه سيصبح عاجزاً تماماً عن السير من حالة إلى أُخرى أكثر تطوراً وكمالاً خلال سيره الارتقائي في حركة الحياة.. وربما يكون مصيره الانقراض الوجودي – إذا جاز التعبير – عندما يعجز عن تلبية احتياجات التطور الكوني والوجودي المستمر والمتواصل.
من هنا بالذات كان اهتمام وتركيز الإسلام – كدين مدرحي (مادي، روحي) – في تربية الفرد المسلم على ممارسة الإعداد الروحي والبناء الأخلاقي المتين، وتوعية الإنسان المسلم على حقائق الحياة والوجود، كجزء أساسي من مسيرته التكاملية نحو تمثل وتجسيد قيم العدل والتوازن والمساواة في السياسة والاجتماع والاقتصاد و.. إلخ. فبناء النفس وتنمية الروح (والأخلاق المعنوية الذاتية) هو أساس بناء وتنمية الواقع الخارجي؛ ليكون بالتالي تغيير ما بالنفس هو الأساس لتغيير ما بالواقع.
من هنا جاء تركيز الإسلام على ضرورة تعميق منهج وخط الإعداد الروحي عند الإنسان المسلم (الجهاد الأكبر)، ليكون ذلك مقدمة لازمة حيوية لتغيير الحياة والواقع في التجاه الذي يحقق كرامة الإنسان وعدالة الحياة والوجود.
ولذلك عندما يصبح حق ممارسة النقد والرفض، والمعارضة العلنية والتدخل، والأمر بالمعروف، ومعارضة السلطة الظالمة، ومواجهة السلطان الجائر والفاسد، من الواجبات الأساسية التي يجب العمل على تركيزها في واقع وحركة الأُمّة (كواقع عملي يؤسس لتشكيل الفعل الجماعي)، فلا يمكن الحديث بعد ذلك من مشروع الدولة الشمولية وسلطتها المستقلة والمنفصلة عن المجتمع والأُمّة. أيّ الدولة المشخصة التي تقوم على نفي حرية الفرد، ومصادرة وجود الناس، ورهن إرادتهم لها، وإلغاء أي دور لأفراد المجتمع في تداول السلطة، وعدم اعتبار الأُمّة مصدراً للحكم والسلطة، مما يفقد هذه السلطة شرعية الوجود في الوجدان المجتمعي الشعبي.
إنّ السلطة القائمة (أيّة سلطة) لا تصبح شرعية في وجودها وعملها (وتحظى برضا الأُمّة والشعب) إلا عندما تقوم على احترام حق المجتمع في معارضة توجهاتها المختلفة، ونقد سياساتها العملية، بحيث يكون هذا الحق سلطة قانونية موازية لسلطة الدولة نفسها.
ويبدو لنا أنّ سيطرة العقلية القبلية على قطاعات واسعة من أجهزة الحكم السياسي العربي والإسلامي بكل أجوائه وامتداداته، تشكل إحدى أهم المسببات الرئيسية لأزمات واقعنا المتلاحقة، التي تكبله وتمنعه من الانطلاق نحو مواقع العمل والإنتاج، وترهن وجوده لصالح نزعات طغيانية ذاتية ليس لأصحابها من همٍّ سوى تكريس مصالحهم وأهوائهم، على حساب الدولة والأُمّة كله.
لكننا نجد هنا ضرورة الإشارة إلى أن امتداد جذور هذه الأزمة – التي تعصف بمجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم – قد أدى إلى بناء حداثة قشرية مشوهة وغير نظيفة في تلك المجتمعات. لذلك ليس هناك من أمل للخروج من هذه الأزمة العميقة (وحداثتها المزيفة الكسيحة) إلّا بتوجيه سهام النقد الموضوعي إلى الجذور النفسية والفكرية التي أنتجت وولدت هذه الحداثة، وتهيئة شروط جديدة لتجاوزها، والخروج من أخطارها المقيمة والداهمة. والواجب يقتضي منا – في هذا المجال – العمل على إنجاز ما يلي:
1- نقد الدولة الوطنية الحديثة بالذات، في مفهومها، ومصدر قيمها.
2- نقد عقيدة ارتباط التقدم التاريخي بالدولة.
3- نقد فكرة تعظيم دور الطليعة الحزبية المغلقة، والإدارات القائمة، وفضح تضخيمها لأجهزة القمع، والضبط، والردع، والكبت بوسائلها الخاصة والعامة، التي أصبحت إستراتيجية سياسية وثقافية عامة للدولة الوطنية والقومية والإسلامية الحديثة، بحيث بات معدل بناء السجون والمعتقلات، وشيوع المنافي الصحراوية، وتمدد معسكرات المراقبة والتجميع ونقاط التفتيش، وتعاظم أجهزة الأمن، أكبر بكثير من معدل بناء المستشفيات والمدارس المراكز الثقافية والجامعات وباقي مرافق الخدمات الاجتماعية الأُخرى.
ومن الواضح أنّه لولا وجود حداثة فكرية مشوشة ومشوهة لدى النخب الحاكمة، ما كانت الأمور وصلت إلى هذه الدرجة من السوء والانهيار الشامل، لا صوت يعلو فيه فوق صوت العاطفة.. وحتى تسترجع مجتمعاتنا صدقيتها الداخلية والخارجية – على صعيد بناء وجودها العملي الفاعل والمؤثر – ليس لها من سبيل سوى ارتفاع نخبها الفكرية والسياسية إلى مستوى المرحلة والتحديات الكونية الهائلة، واستعادتها لمعاني المسؤولية الوطنية، وإظهار قدرتها على إحداث تغيير حقيقي جذري في أساليب الحُكم والإدارة، وفي نوعية السياسات والاستراتيجيات (التي سبق أن رسمت في ظروف ومواقع وأدوار مختلفة كلياً عن الراهن، والتي قادتنا جميعاً إلى حالة انسداد الآفاق، وتفجر الأزمات) والعودة إلى اعتماد طريق الإدارة الحديثة القائمة على معايير الكفاءة والنزاهة والقانون وتكافؤ الفرص، بدل معايير الزبونية والمحسوبية والعلاقات ما قبل وطنية.
وفي هذا الاتجاه نجد أنّه من الضروري جدّاً العمل – على هذا المستوى – باتجاهين اثنين يكمل أحدهما الآخر، ويلازمه، حيث إنّ مجتمعاتنا تعيش هاجس التاريخ والرسالات والأنبياء:
الأوّل: اتجاه التأويل، أي تأويل النصوص الإسلامية لمصلحة تعزيز سلطة المجتمع وحرية الفرد والجماعة، وتثبيت حق النقض والاعتراض والتصويت والتصحيح، وحتى الثورة على الحاكم الجائر وتغييره. وإلى ما هنالك من حقوق هائلة على نحو لا يخرج هذه النصوص عن دلالاتها الحية الصريحة.
الثاني: تنظيم واجب التبليغ والدعوة في المجال الإجرائي والعملي، من خلال إعادة النظر في مهمة المبلغ نفسها، وذلك بالعودة إلى الينابيع والأصول التي أعطت لهذه المهمة الرسالية صفة السلطة الموازية، وإقامتها على قاعدة الحرية والمسؤولية، وعلى مبدأ (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)، بحيث يكون لكل فرد من أفراد المجتمع والأُمّة – ما دام يمتلك حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – سلطة عامة هي سلطة النقد غير المحصورة، والتي تطال كل الدوائر في المجتمع وفي الدولة.
وبهذا المعنى يكون كل فرد عضواً فعالاً في السلطة، ومسؤولاً أمام الله والمجتمع، عليه القيام بواجب ومسؤولية ممارسة أشكال النقد والمعارضة المختلفة في كل حقول التوجيه الروحي والمادي إعلاءً لقيم الأُمّة وأهدافها الرسالية العليا في إقامة الحق والعدل.
من هنا نجد أهمية الربط بين الممارسات النقدية المسؤولة التي يقوم بها الدعاة والمبلغون وبين المؤسسات الأهلية القائمة في المجتمع، وما يرتبط فيها من هيئات وقوى وتيارات تناهض (وتجاهد) من أجل تحديث المجتمع السياسي، وتعميم الحريات السياسية للفرد والمجتمع، والداعية إلى مبدأ تداول السلطة وإصلاحها واسترداد شرعيتها، وإرجاعها إلى قلب الأُمّة: لأنّ في هذا الربط بين مهمة المبلغ وبين المهمات الاجتماعية والسياسية الحيوية تجديداً لدور المبلغ في مجال ترسيخ الحس النقدي لدى أبناء المجتمع، وممارسة حق المعارضة السليمة، واستنفاداً لهذا الدور من هامشيته التاريخية المستمرة والمتواصلة حتى الآن، ووضعاً له في موضعه الطبيعي من حياة الناس وهمومهم الجدية والمصيرية.
إننا نعتقد أنّ أيّة دعوة رسالية تستهدف ترسيخ قيم الحرية والعدل والمحبة والخير للناس جميعاً لابدّ أن تواجه بمصاعب وتحديات جمة من قبل الكافرين والحاقدين والظالمين. لذلك يجب على العاملين السائرين في هذا الطريق الصعب والطويل، أن يشعروا جدياً بأنّ العمل في سبيل الله والحياة والناس يكلف صاحبه كثيراً من الدموع والدماء، وهو بالتالي ليس نزهة يرفه فيها عن نفسه هنا وهناك. وبهذا المعنى لا يعود العمل الرسالي مجرد صرخة في فضاء المساجد والحوزات، أو دعوة (دينية) ساذجة خالية من أي عقل يفكر، أو إحساس يعي، أو معنى يتحرك، ولكنه – كما هو في مفهومه الحقيقي الأصيل – أن تقف في ساحة الحياة لتنظر في مواقعها وأوضاعها الظاهرة والمخفية، ولتدرس كل انحرافاتها، وتعمل على نقدها ومواجهتها، والتخلص منها بوعي وثقة وثبات. ثمّ تنطلق بعملية المواجهة الصادقة ضد كل أنواع الظلم ومختلف نماذجه وأساليبه سواء على المستوى الفردي في علاقتك مع نفسك وعلاقات الأفراد بعضهم، ببعض، أو على المستوى الاجتماعي في علاقة الجماعات مع بعضها بعضاً، وفي أوضاع الحكم والحاكمين، وعلاقة الحكم القائم بالشعب، وعلاقات الدول ببعضها.
إنّ الإنسان الرسالي الذي يريد أن يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من الوعي الفاعل والهادف لابدّ أن يؤسس بنيانه وكيانه النفسي والعملي على الانسجام والتوازن النفسي والروحي، وعلى محبة الله والحياة والإنسانية، من خلال تعميق ثقافة تقوى الله وخدمة الناس والصالح العام؛ لكي يكون بمقدوره تحمّل كل الضغوط والمشاكل بصلابة وعزيمة، فلا ينحني أمامها بضعف واهتزاز، بل يحاول أن يقتحمها بقوة وتصميم على النجاح والفوز الأكيد.
إذن، فالمطلوب من الإنسان الرسالي هو:
1- أن يقف مع الإنسان المستضعف والأُمّة المستضعفة قلباً وقالباً، ووعياً وسلوكاً وحركة، فيتحسّس آلام الناس المستضعفين، ويلامس معاناتهم، ويعايش قضاياهم الخاصة والعامة، ويتحمل في سبيلهم كل أنواع التحديات والمشاكل النفسية والعملية.
2- أن يربي الأُمّة ويصوغها رسالياً بالمستوى الذي تستطيع فيه أن تملك قوة الموقف، وصلابة المبدأ والإدارة لتسقط الحكم الظالم والمتجبر.. وتزيله من مواقعه التي يريد الوصول من خلالها إلى مصالحه الخاصة.
3- أن يمتلك ثقافة الحياة والعصر الذي يعيش فيه؛ ليكون قادراً على امتلاك أُسس التعامل معها بتنوعاتها وأحوالها المختلفة، من أجل فهم ودراسة شروط ومناخات إدخال الفكر الإسلامي إلى ذهنية العالم المعاصر بالطريقة التي تحقق له الكثير من النتائج الإيجابية على المستوى الروحي والمفاهيمي.►
*باحث وكاتب من سورية
المصدر: مجلة المنهاج/ العدد 48 لسنة 2008م
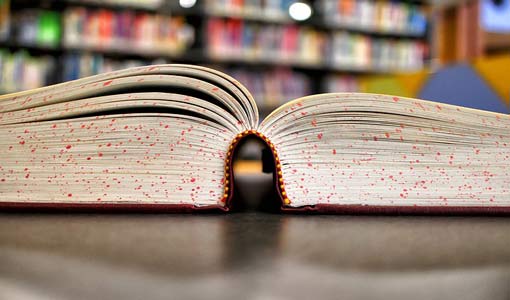
ارسال التعليق