- ٢١ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
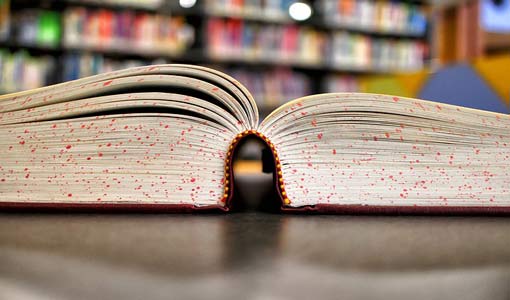
النقد الفني اجمالا، والأدبي على وجه الخصوص، ليس جديداً على الثقافة العربية. منذ أن كان شعراء العرب يتهاجون ويتفاخرون، فيحكم بينهم الحاكمون كان هناك نقد. منذ أن وجدت أسواق العرب الثقافية – وهي تكاد تكون فريدة في التاريخ – كان النقد ملازماً لها، أو منظّماً لأعمالها، واسطع مثال سوق عكاظ. والأمر هنا، لعلّه يقدم دليلا حول التركيبة الذهنية للعقلية العربية باعتبارها عقلية ناقدة، محلّلة، دراسة، عكس ما تذهب إليه الإدعاءات الغربية. على أي حال فليس هذا مقام هذا المقال.
النقد، إذن، ملازم لحركة الثقافة العربية، لانطلاقتها ولنهضتها، وفي كافة تجلياتها: نثر، شعر، رسائل، سير، فنون إلخ..
ومن الثابت، انّ الإبداع يسبق النقد، في جميع الأحوال والأوقات، حيث يولد فيما بعد التجاذب بين الابداع والنقد.. هذه الاشكالية، اشكالية التجاذب، طرحت نفسها في الغرب، فدار السجال الثقافي بين من يقول انّ النقد منقاد للنتاج الأدبي أو الفني، تابع له، أو مستقل بذاته.. إلى أن ظهرت مدارس مستقلة في النقد وتوسعت بعد الحرب العالمية الأولى، ثمّ ظهرت أخيراً مدارس النقد المنهجي، أو العلمي، الآتية أساساً من دراسات علم الاجتماع الحديث.
أما في التراث الثقافي والأدبي العربي، فإن اشكالية التجاذب، أو مشكلة الانقياد والتبعية، من جانب النقد للابداع، فلم تكن موجودة، أو مطروحة. قد يكون هذا الاجتهاد، جديداً في السجال الثقافي الدائر حول التراث العربي، لكن مبرّره، يكمن، في تلمس اسس حركة النقد التي لازمت النهضة الثقافية العربية، كما سبق..
إنّ النقد، العربي الهوية والمضمون، كان بحدّ ذاته عملاً إبداعياً، أو نتاجاً فنياً. فقد كان لكل قبيلة عربية – في مجال الشعر – لسان حالها، ينطق باسمها، يدافع عن حقوقها، يبيّن خصالها، ويهجو أعداءها. وكان ما ينطق به هذا الشاعر، معرّضا للنقد من شاعر آخر، هو في الوقت عينه، ناطق بلسان قبيلة ثانية، وحامل أمانة الدفاع عنها وردّ أقوال المتقولين عليها.. هكذا كانت حال عنترة العبس، والسموأل، وامرئ القيسء، قبل الإسلام، وأبي الطيّب، وجرير، والفرزدق، بعده.
إذن، فأعمال النقد كانت تحمل ذات الخصائص، والسمات والصفات، للأعمال المنقودة. فهي – والحال كذلك – نتاجات ابداعية نقدية لمبدعين ناقدين. ووصل الأمر بعد الإسلام، ومع تطوّر الدولة العربية الإسلامية، إلى حدّ اكتساب النقد صفة النقض، بمعنى أنّ القصائد التي وضعت للرد على قصائد قيلت، وضعت بهدف نقضها، والنقض هنا متضمن معنى النقد، وتبقى نقائض جرير والفرزدق والاخطل في العهد الأموي، بمجملها، منارة العربي. أما ما خرج عن هذه القاعدة النقدية – الإبداعية، المنهجية، فانّه جاء عاما، أو بمثابة شهادة براءة للشعراء.. وقد صيغ مجمل هذا النوع من النقد، على وزن افعل التفضيل، كالقول بأن فلانا اشعر من فلان.
المفارقة أن بعض الناقدين العرب، المعاصرين، يشعرون انّهم يتعاملون مع مهنة بلا قواعد أو أصول. أي بلا منهجية نقدية ذاتية، خاصة بالتراث الابداعي العربي وبالنتاج الجديد. فلجأ البعض إلى التقييم العشوائي، أو الذاتي، ويستعير البعض الآخر من الغرب أساليبه وأدواته لاستخدامها في تقييم أعمال أدبية أو فنية، تختلف نوعيا من المادة التي تعامل معها الناقد الأوروبي الغربي. من هؤلاء الدكتور طه حسين، الذي تبنى منهج الشك الديكارتي، في دراسته التحقيقية للأدب العربي. ومنهم نفر من الناقدين الجدد، الذين يعتبرون مدارس النقد الأوروبية الحديثة، خصوصاً النفسية منها، أدوات التقييم الوحيدة لكل لمحة فنية أو أدبية.
- المشكلة:
المشكلة تبدو هنا معقدة، كونها فرع من مشكلة الانبهار العام بكل ما هو آت من الغرب. ولكن حتى لا يكون هذا التعميم. دعوة لرفض الغرب ومنتجاته، ثقافية أو غير ثقافية، لابدّ من القول انّ الأدب هو ابن البيئة، ابن الواقع. فهو كموضوع قابل للاستيعاب أو الدرس، يتضمن خصائص بيئوية، تشكل المدخل للتعامل معه. فهل يلغي هذا الكلام، مبدأ "عالمية الأدب"؟
بلا مغالاة، تبدو الأعمال الأدبية، أو الفنية الأخرى، التي اكتسبت صفة العالمية، قد اكتسبت من هذه الصفة بعض الخصائص، التي تؤهلها لتقديم نفسها لقرّاء مختلفي اللغات، فيتقبلونها بخصائصها الفنية المشتركة، الجامعة، متولين عن قصورها في تقديم مشكلة، انسانية، شمولية، عامة، تخصّهم. ينطبق هذا الكلام على أعمال شكسبير، هوغو، دانتي وغيرهم.. الذين سمت أعمالهم في سماء العالم..
فالأدب العالمي، يتميّز، بخصائص عالمية، تجمع الدراسات الحديثة على وضع الجمالية في مقدمتها. في هذا المنحى ذهب ديكارت صاحب الدراسات الجمالية في النقد. وفسّر الأب اندريه، الجمالية بقوله: "الجميل هو المطلق، الخلقي، القومي، الروحي، الضروري، الموسيقي المعقولي، المرئي". ومؤكد أنّ الجمالية، كخاصية ومفهوم، هي مسألة موافقة لنمو الحسّ البشري، والوعي. وقد كان لدى هيرودوتس – كما قيل عنه – البراعة في ان يغرم بالأشياء التي ظل الناس يغرمون بها لمدة 230 سنة.
وحول هذه الخاصية، عقدت مختلف الدراسات النظرية الخاصة بالأدب الأوروبي، العالمي، ونبغ فيها عدد كبير من الباحثين أمثال: مارسيل بروست، اندريه جيد، بول فاليري..
- التصوّر:
عندما نقول انّ الأدب ابن البيئة، أو الواقع، نقصد تحميل الأدب مسؤولية طرح هموم البيئة بالشكل المناسب.
وهذه المهمة ليست مقصورة على أدب وطني أو قومي بذاته. انها مهمة "عالمية"، من حيث ضروريتها لكل أدب أيا تتكن هويته، في هذا تحدث سانت بوف أستاذ النقّاد الغربيين، فبيّن نقائص النقد المطلق، دونما السقوط في الذاتية، بحسب اتهامات البعض. ولا شك، أنّ النتائج التي توصّل إليها سانت بوف، قد لاقت التطوير على أيدي أساتذة آخرين، امثال فيلمان وتين وهينكان وبورجيه، وكل دعاة النقد الوضعي، الذين حرصوا على الموضوعية، فدعوا إلى موقف علمي من المادة الموضوعة للتفسير قبل الحكم، والتي تهدف إلى الكشف، من خلال التحليل، عن العلاقة التي تربط الأثر بظروفه وتعطيه نسبيته الجوهرية.
فالمهمة العالمية "البيئوية" التي حمّلناها للأدب، وتاليا للنقد، ليست خاصة بالأدب العربي مثلا، بل انّ الغربيين يجرون وراءها، وظهرت مدارس لديهم تعتمد هذه النظرية توصلا إلى التزام منهج التوضيح العلمي على المؤلفات الأدبية. ويعرّف الاستاذان كارلوني وفيللوا هذا المنهج، في كتابهما "النقد الأدبي" على النحو التالي:
أولاً: انّ الأثر هو حدث محتمل، انتاج الإنسان التاريخي، والنفسي، الاجتماعي.
ثانياً: انّ هذا الحدث يجب أن يتلقى من النقد تفسيراً.
ثالثاً: انّ الحكم النقدي لا يمكن أن يكون الا حكماً موضوعياً، تتخذ معاييره من التفسير نفسه.
- الحلّ:
للنقد مهمتان مختلفتان: مهمة التفسير ومهمة الحكم. بهذا قال كبار النقاد الكلاسيكيين، ومنهم أحمد أمين. ولكن هل تبدّلت هذه القاعدة الكلاسيكية مع تقدم الزمن؟ أليس مطلوباً من كل ناقد، ان يكشف ماذا أراد الفنان أن يقول في عمله. أي أفكار الفنان من خلال التجسيم الفني لها: شعرا، أو مسرحاً، أو موسيقى، أو نحتا إلخ.. هذا المدخل، هو الذي يوصل الناقد إلى فضاء رحب لمناقشة المضامين الفنية، منفردة أو مجتمعة، وصيغة تركيبها، وبنائها، ثمّ – إذا أراد – البحث في إمكانية ملاءمة الألفاظ، أو الألوان، أو المواد، المستعملة في العمل الفني.
وبافتراض ضروري، انّ الناقد يتمتع بصفات الموضوعية، والتجرّد، والمعرفة، والعلمية – وهي صفات لازمة لكل ناقد – فإنّه في مهمته لابدّ أن يكون أمام عمل فني نابع من البيئة. ناقلاً لمشكلة، أو طارحاً لتصوّر الحل، أو مبيّنا أسلوب العمل لتحقيق الحل والغاء المشكلة. أو انّه أمام عمل فني يتضمن العناصر الثلاثة المذكورة معاً.
انّ الناقد في هذا الموقف، هو بلا شك أمام عمل فني تقدمي الغاية والقصد، وهو ما يفرض عليه أن يسمو إلى قيمة العمل الذي بين يديه، فلا يسلبه قيمته بالطرح المباشر لفكرته، أو يضيف إليه ما ليس منه، أو يعاتب أو يعاقب الفنان، على طريقته في التعبير، كأن يلومه على السرعة في موقف، أو الاختصار في موقف آخر.. فمهمة الناقد هي في حدود العمل الفني، وظروفه، وأسباب وضعه، وما يهدف إليه. ويبلغ العمل النقدي ذروته، عندما يكشف المحور الذي يدور عليه العمل الفني: أ هو مشكلة، والفنان هو الاقدر بين الناس على اكتشاف المشكلات مهما صغرت.. أ هو تصوّر للحل، ولعل الفنان هو الاقدر على أن يثير في أذهان الناس التصوّر إلى الحل المطلوب للمشكلة، أ هو تبيان لطريقة تحقيق الحل، والخيال الفني قادر على أن يبث حماس العمل بالمشاهد أو القارئ..
الناقد عندما يتصدى لهذه المهمة، فانّه يتسلّح بمنهج علمي للتعامل مع العمل الفني، لأن الفنان، أراد أم رفض، يتعامل مع الواقع بمنهج علمي جدلي، فيما خلا الأعمال الفنية الهابطة، التي يمكن وسمها بصفة الرجعية.. ذلك انّ الفنان، كما يقول الدكتور عصمت سيف الدولة (مقال في النقد الفني، في كتابه "اعدام السجان" – دار المسيرة) "الفنان، ككل إنسان، لا يستطيع أن يفلت من القوانين الموضوعية. التي تحكم الوجود معه. فهو يؤثر ويتأثر.. وهو يتغير.. وهو يتحرك.. مثله كمثل كل شيء. ثمّ انه يختصّ، دون جميع الموجودات، بقانونه الذي يضبط حركته. انه كائن جدلي".
حينما يقدم الفنان والناقد، على عمل ابداعي ما، فإنّ الواحد منهما لا يستطيع أن يفلت من قوانين حركة الإ،سان. ومن شأن ذلك أن يجعلهما يعودان إلى الواقع للتفتيش عن محرك محوري لنشاطهما الفني: مشكلة، تصوّر حل، أو عمل.. وهذا المنهج يحصّن الفنان وتباعا الناقد، من أي اسقاط نظري عليهما، يصفهما بالذاتية بدعوى العالمية، أو بالرجعية بدعوة الواقعية الاشتراكية إلخ..
من هنا، سبق القول انّ النقد "ملازم لحركة الثقافة العربية" وسمة للتراث والعقل العربيين، فقد تميّز التراث العربي ومعه العقل العربي بواقعية اكتسبها بفضل قسوة الظروف.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق