- ١٨ كانون أول/ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦ جمادى الثانية ١٤٤٦ هـ
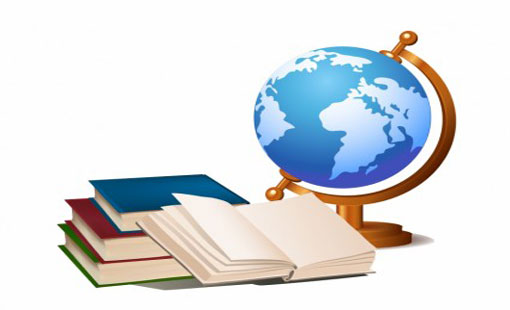
◄على المؤرخ، عند تحليله وثيقة من أجل (حقائقها) المفردة أن يقترب منها وهو يحمل في نفسه سؤالاً أو مجموعة من الأسئلة، دون أن يربط نفسه باتجاه معين (على سبيل المثال: هل حاول شاؤول اغتيال داود؟ ما هي تفاصيل حياة كاتيلاين Catiline؟ مَن هم رفاق تنكرد Tancred في حملته الصليبية؟) ويلاحظ بالطبع أنّه لا يمكن لأحد أن يسأل حتى أبسط الأسئلة ـ مثل هذه ـ دون أن يعرف ما فيه الكفاية عن المشكلة التاريخية لكي يسأل الأسئلة التي تدور حولها، وإذا توفرت للمرء معرفة كافية ليسأل حتى أبسط تلك الأسئلة، فإنّ هذا يعني أنّه لابدّ أن تكون لديه فكرة ما وربما بعض الفروض المتعلقة بها، سواء أكان ذلك مفهوماً ضمناً أو واضحاً، وسواء أكان حدساً أو مُعداً ومحدداً وثابتاً.
أو قد يكون (الفرض) مكمّلاً، على الرغم من أنّه ما يزال مضمراً وفي صيغة الاستفهام (مثال ذلك: هل كانت المدينة في العصور الوسطى متطورة عن السوق؟ لماذا كان منكرو تعميد (عند المسيحيين: غَسَلَه بماء المعمودية، فهو مُعْمَّدٌ) الأطفال يؤمنون بالحرّية الدينية؟ كيف ساعدت المساهمة في الثورة الأمريكية على نشر الأفكار الحرة بين الأرستوقراطيين الفرنسيين؟).
وهاهو (هيغل) يحذرنا من أن نقع في الخطأ الذي كثيراً ما يقع فيه المؤرخون المحترفون (خصوصاً بين الألمان) مثل اختراع أفكار قبلية وحشرها في وثائق الماضي. كما أنّه يحذرنا من ناحية أخرى من (الروايات الخرافية) التي تنتشر انتشاراً واسع المدى بين الناس، لكنّها مع ذلك لا تعدّ من التاريخ، ومن أمثال هذه الروايات ما يرويه (اليهود) عن أنفسهم من أنّهم شعب مختار تعلّمَ من الله بطريقة مباشرة ومنه الله بصيرة كاملة، وحكمة، ومعرفة تامة بجميع القوانين الطبيعية وبالحقيقة الروحية، بل إنّهم يتمادون في رواياتهم، فيزعمون أنّ الله تحدّث إلى آدم (باللغة العبرية)، لكي تصبح لغتهم بدورها هي (لغة الله المختارة)!
ومن هنا جعل (هيغل) أوّل شرط يجب مراعاته في فلسفة التاريخ هو: أن نتبنى (بأمانة) كلّ ما هو تاريخي بمعنى: أن تخلو العبارة التاريخية من الأفكار والاختراعات الذاتية.
على أنّنا نضيف هنا إلى ذلك، أنّ المؤرخ (المحايد) يجب أن تكون له وجهة نظر خاصّة ولا يكون مجرد جهاز تسجيل يقف بسلبيته أمام ما يقدم إليه من أحداث التاريخ مكتفياً بالتسجيل فقط، بل إنّنا نقصد بحياده أن يسهم بأمانة في الكشف عن القوانين الصحيحة التي توجه مسار التاريخ.
ومن الواجب أن يكون المؤرخ مُنزهاً عن الكذب الذي يقام في أساسه على الأثرة وحبّ الذات والسير وراء الأهواء والأغراض والمنافع الخاصّة حتى لا تشيع الشائعات بهذا الكذب وتتناقله الأفواه ويسجّله الرُّواة في ما يسجّلون من الروايات والأخبار. وحينئذ يختلط الحقّ بالباطل وتعمى المسالك على الباحثين، حتى لقد يصبح البريء ـ أحياناً ـ مُسيئاً والمسيء بريئاً. ويوصف الظلم والطغيان بأنّه عدل وإحسان.
إنّ أوّل مرحلة من مراحل نقد الأصول التاريخية هي إثبات صحّتها، لأنّه إذا كان الأصل أو المصدر كلّه أو بعضه (مزيفاً) أو (منتحلاً) فلا يمكن الاعتماد عليه على وجه العموم. صحيح أن تزييف الأصول والوثائق صار اليوم أصعب منه في الماضي، ولكن دوافع التزييف والدس لا تزال قائمة.
وقد تزيّف (الآثار المادّية) في أحوال كثيرة لدوافع مختلفة، ومن أمثلة ذلك ما حدث من وجود مجموعة من الأواني والأدوات الفخارية في مدينة القدس سنة 1872م، وقد دلّ على وجودها (سليم العربي) الذي كان يعمل في خدمة بعض المنقبين عن الآثار في فلسطين، واشترى بعضها متحف برلين؛ ولكن البحث العلمي أثبت أنّ هذه الآثار مزيفة.
وقد تزيف الكتابات التاريخية والوثائق في أحوال كثيرة لدوافع مختلفة، ومن أمثلة ذلك مجموعة من الخطابات والتواريخ والأشعار طُبعت في إيطاليا بين عامي 1863 ـ 1865م على أساس أنّها كتبت عن جزيرة (سردينيا) في الفترة بين القرنين الثامن والخامس عشر، وبعد فحص (العلماء) لها وجدوا أنّ ما جاء بها لا يطابق ولا يشابه ما عرف عن خطوط سردينيا وتاريخها في أثناء تلك الفترة. ومن ثمّ قرروا أنّها مزيفة وغير حقيقية.
إنّ السّر في سلامة الفكر التاريخي في الإسلام، هو في الدرجة الأولى: (نفي الظن) من جهة، والابتعاد عن (هوى النفس) من جهة أخرى والتشدّد في إحراز العلم أو (اليقين) من جهة أخرى.
قال تعالى: (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (النجم/ 28).
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) (الحجرات/ 6).
وهكذا نقول، إذا كان للتاريخ أن يكون علماً، إذن، فعلى المؤرخ أن يكون ذا بصرٍ، ذا لبٍّ، ليتمكن من استلال العبرة، من تبيّن الحقيقة، وإقصاء الأوهام.
وفي مناهج البحث التاريخي عند المسلمين، يحرص المؤرخ أن يكون (محايداً).. ومتجرداً من الأهواء، غير منغمس في عصبية لفئة أو حزب أو طبقة، فإذا تحيز أفقد أقواله وأحكامه كلّ قيمة، وكان تحيزه سباً في إثارة شكوك العلماء وتضليل الجهلاء.
فقد ذكر القرآن الكريم في مواضع مختلفة منه، وجوب التثبت من الأنباء والشهادة كما رأينا في سورة الحجرات، فدلّ بذلك على أنّ خبر الفاسق يقتضي التبيّن، وأنّ شهادة غير العدل مردودة. وللرسول (ص) أحاديث منها: "مَن حدّث عني بحديث يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين"، و"سيكون في آخر أُمّتي أُناس يحدّثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم".
وقد اتّبع ابن خلدون منهج النقد والاستقصاء والملاحظة توصلاً إلى نقد الأخبار نقداً علمياً، ونقد الطُّرق المتبعة عند المؤرخين والتعرّف إلى مواطن الخبر، واستقصاء مظانّه، ومناقشة الروايات، والمقارنة بينها، وبذلك تكمل الرواية وتحقق الدراية ما عسى أن يكون في (الخبر) من تحريف أو مبالغة أو تزوير إذ كثيراً ما يتطرق (الكذب) إلى الروايات تشيعاً لرأي أو زلفى لحاكم أو رئيس وما إلى ذلك.
فهناك صنّاع للأخبار والروايات يدسون ويزيفون لحاجة في نفوسهم. وما أحوج المؤرخ إلى اطلاع واسع ومعرفة مستفيضة تعينه على النقد والتمحيص، ولابدّ له أيضاً من دقّة في الملاحظة تكشف له عن الأمور الثابتة والعرضية وتقيس الغائب بالشاهد، فتقارن بينهما وتوازن لمعرفة ما بين الشاهد والغائب من الوفاق، أو بَونَ ما بينهما من الخلاف، وتعليل ما يتفق منهما وما يختلف.
وهكذا فإنّه (كثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً، لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحقّ وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، ولاسيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر، ولابدّ من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد).
فمن ذلك ما نقله المسعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بني إسرائيل. فلقد رووا أنّ موسى (ع) أحصاهم في التيه بعد أن أبقى منهم مَن يطيق حمل السلاح وهم الشبان الأقوياء الذي بلغوا سن العشرين فما فوقها ولم يدركهم ضعف الشيخوخة فوجدهم ستمائة ألف أو يزيدون.
ويقول (ابن خلدون): إنّ المبالغة في هذا الرقم واضحة، وإنّ تحديد الجيش بهذا العدد أمر غير معقول، وإنّ القوانين التي يخضع لها تزايد السكان تحكم بعدم إمكان صحّته.. ذلك أنّ ما بين موسى ويعقوب (ع) هو أربعة آباء فحسب، فموسى هو بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب.
وقد كان مقامهم بمصر منذ دخل يعقوب إليها هو وأولاده إلى أن خرجوا منها مع موسى (ع) إلى التيه في شبه جزيرة سيناء، كان مقامهم في مصر مائتين وعشرين سنة، فإذا كان عددهم حينما دخلوا مصر سبعين نفساً ـ كما ذكرت الروايات المختلفة ـ فمن المستحيل أن يتشعب هذا النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد الضخم أي يزيد عدده إلى ما يساويه عشرة آلاف مرة.. من المستحيل أن يكون ذلك بحسب القوانين التي يسير عليها التزايد في النوع الإنساني.
ولاشك أنّ كلام (ابن خلدون) يتمشى مع المنطق السليم، ولو أنّ المسعودي وغيره من المؤرخين الذين نقلوا هذه الرواية على ما فيها من مبالغة واضحة بل كذب لاريب فيه.. لو أنّهم تأمّلوا قليلاً في مثل هذه الأخبار، ونظروا حالة المجتمع في هذا العصر الذي يتحدّثون عنه، وعرفوا أنّ فرعون في مصر كان يضطهد بني إسرائيل في هذه الفترة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وعرفوا أنّ تزايد النوع الإنساني مهما كان فله نسبة خاصّة لا يتعداها.. لأدركوا أنّه لا يمكن أن يصير عدد جيش بني إسرائيل في مائتين وعشرين سنة إلى ستمائة ألف، وأنّ غاية ما يمكن أن يصل إليه عددهم جميعاً هو ثلاثون ألفاً ما بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ كبار، وأنّ عدد الجيش ممن يطيقون حمل السلاح لا يمكن ـ حينئذ ـ أن يزيد على خُمس هذا العدد أي ستة آلاف فحسب.
ألا ما أبعد الفرق بين الستة آلاف والستمائة ألف.. ويا لها من مبالغة ممقوتة، تمسخ الواقع مسخاً، وتذهب معها الحقيقة أدراج الرياح.
ومسألة التحقق العلمي من (المادّة التاريخية) أمر ضروري لكلّ مؤرخ. ويذهب أحدهم إلى أنّ النقاط التالية هي أهم وسائل التحقق العلمي من سلامة المعلومة التاريخية:
ـ المشاهدة والاختبار: ويقضيان القيام بدراسة مفصلة للمعطيات المتوفّرة وجمع المزيد منها، أو القيام بفحص المادّة التاريخية فحصاً دقيقاً.
ـ الحساب الرياضي: تفيد المعالجات الرياضية في التأكد من كيفية حدوث واقعة ما في الماضي.
ـ التحقق بالاستبعاد: قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع الفرضيات التي تنافسها، فالتحقق السلبي من النظريات المنافسة يصبح تحققاً إيجابياً للفرضية التي لا يمكن استبعادها، وللتأكد من هذا يمكننا عادةً أن نجد شواهد أخرى تؤيد مثل تلك الفرضيات، لكن الاستبعاد يمكن كثيراً للفرضية الباقية. وهنا أيضاً نتبيّن أنّ النفي مهم للغاية في نمو المعرفة.
ـ التحقق بالتفكير الفاصل: وتحقق الفرضية أحياناً عندما نتبيّن أنّها الفرضية الوحيدة التي تتسق مع ما قد جرت معرفته في ميدان المعرفة التي تنتمي إليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع.
ـ الموضوعية واليقين والقيم:
على المؤرخ أن يكون موضوعياً تماماً أو متحمساً كما يشاء في تطلعه إلى استكشاف شواهد تبرهن نظرية معينة أو تنقضها. فالموضوعية تتطلب منّا أن نكون على استعداد لأن نستبعد ـ على أساس الشواهد ـ أحب الفرضيات إلينا، وعليه ينبغي على المؤرخ أن يميِّز العنصر الذاتي في البحث الموضوعي ليحول دون تشويه الموضوع بتحيّزه. ويستطيع (المؤرخ) أن يفترض درجة أعلى من الاحتمال أو الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند تجريبي فحسب، بل وعندما تتفق مع نظرية معتمدة في التاريخ والعلم الاجتماعي، وبذلك نكون قد عرضنا نظرية في المعرفة التاريخية؛ ولكنّها لا تضع في متناولنا حلاً سهلاً لمشكلة (وزن الشواهد التاريخية) و(معدل الصدق واليقين) في الدوافع المختلطة عند المؤرخ والمؤثرات في شخصيته، أو التغييرات في (السجلات القديمة).
ولما كان المؤرخون في الحقيقة يضعون أحكاماً فقد أصبحت (القيم) والمقاييس النقدية أمراً واجباً، ذلك أنّ التأمّل بلا ضابط في معنى التاريخ معرض للنقد باعتباره شيئاً من قبيل الأماني. ويكون (التحيز) محتملاً.
ومن هنا، كانت القاعدة العامّة عند المؤرخ أن يقف موقف المتشكك مما يرد حتى في أحسن المصادر الثانوية.
وعلى العموم، فإنّ القاعدة المتعلّقة بمرور الفترة الزمنية تطبّق على المصادر الثانوية بخلاف ـ أو على عكس ـ تطبيقها على المصادر الأولية. فكلّما بعدت المصادر الثانوية عن وقت وقوع الحوادث التي تصفها زادت إمكانية الاعتماد عليها وليس السبب في هذا أنّ الاعتدال وعدم التحيّز يقلّان بسبب بُعد الحقبة التاريخية فحسب، بل أيضاً لأنّه بمرور الزمن يزداد احتمال العثور على مادّة أوفر.
ـ معايير تمحيص الأخبار:
وقد وضع ابن خلدون (المعايير) التي يستطيع بها كلّ (مؤرخ) وكلّ قارئ للتاريخ تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. وهذه المعايير قد استفاد (ابن خلدون)، في بعضها على الأقل، من علم الجرح والتعديل في الحديث. وهي على درجات ـ أهمها معرفة (طبائع العمران)، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة، ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أنّ ذلك الخبر في نفسه ممكن أو غير ممتنع.
وأمّا إذا كان ذلك مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ولقد عدّ أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل. وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحّة الأخبار الشرعية لأنّ معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها، وسبيل صحّة الظن الثقة بالرُّواة والعدالة والضبط.
وقد تبيّن لابن خلدون بعد استقراء حوادث التاريخ ودراستها، أنّ أكبر قواعد البحث التاريخي هي أنّ الحوادث يرتبط بعضها ببعض ارتباط العلة بالمعلول. ولذلك نجده في (المقدمة) يقرر استقراءاته في صور قضايا عامّة ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي: (والسبب في ذلك)، (وذلك لأنّ)...
ـ منهجية نقد الرواية التاريخية عند ابن خلدون:
وقد وضع (ابن خلدن) منهجية رائعة لنقد الراية التاريخية والنصوص المختلفة في التفسير والأدب والاجتماعيات، ومما قاله في ذلك:
وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة الفجر في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) (الفجر/ 6-7) فيجعلون لفظة إرم اسماً لمدينة وصفت بأنّها ذات عماد أي أساطين، وينقلون أنّه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان هما شديد وشدّاد ملكاً من بعده، وهلك شديد فخلص المُلك لشداد ودانت له ملوكهم، وسمع وصف الجنّة فقال لأبنيَنَّ مثلها فبنى مدينة (إرم) في صحارى عدن في مدّة ثلثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة سنة، وأنّها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة، ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلّهم. ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزمخشري وغيرهم من المفسرين.
وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض، وصحارى عدن التي زعموا أنّها بُنيت فيها هي في وسط اليمن، وما زال عمرانها متعاقباً والأدلّاء تقصّ طُرُقها من كلّ وجه، ولم يُنقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا من الأُمم، ولو قالوا إنّها درست فيما درس من الآثار لكان أشبه. إلّا أنّ ظاهر كلامهم أنّها موجودة وبعضها يقول إنّها دمشق بناءً على أنّ قوم عاد ملكوها، وقد ينتهي الهذيان ببعضهم إلى أنّها غائبة وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر، مزاعم كلّها أشبه بالخرافات.
والحقيقة فإنّ العماد هي عماد الأخبية بل الخيام وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم بأنّهم أهل بناء وأساطين على العموم بما اشتهر من قوتهم، لا أنّه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها.
ويستطرد (ابن خلدون) في سبيل تحرير المعلومة التاريخية من الأوهام والأغلاط قائلاً: (وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تحملت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحّة).
أدرك (ابن خلدون) كذب هذه الأخبار دون أن يدركها غيره ممن سبق عصره من المؤرخين لأنّه كان على علم بالجغرافيا ومواقع البلدان. وهذا العلم من أهم العلوم اللازمة للمؤرخ كي يستقيم تقديره وتكون أحكامه أبعد عن الوهم وأقرب إلى الصواب ..
ونبدأ بما ذكره المؤرخون من أسباب نكبة البرامكة، وتأتي في مقدمة الأسباب من ناحية الشيوع والرواج قصّة العباسة أخت الرشيد، والعلاقة التي قامت بينها وبين جعفر البرمكي.
ويبدو أنّ الخيال قد لعب في هذه القصّة الدور الأوّل والأخير، وأنّها قصّة مختلقة تماماً، ويستطيع الباحث أن يزكي هذا الاستنتاج بالأمور التالية:
ـ أنكر مسرور الذي قتل جعفراً ـ كما أمره الرشيد ـ قصّة العباسة إنكاراً جازماً.
ـ فوق هذا وذاك فإنّ العباسة كانت متزوجة كما يحدثنا ابن قتيبة في قوله: (أمّا العباسة فزوجها هارون بن محمد بن سليمان فمات عنها زوجها، فزوجها من إبراهيم بن صالح بن علي)، وحقيقة زواجها من هذين الرجلين العباسيين على التوالي تهدم هدماً كاملاً قصّة علاقتها بجعفر البرمكي وما ارتبط بهذه العلاقة من زواج غير معلن، وما نتج عنه من ولد وضعته في أحد القصور العباسية وأسندت تربيته إلى اثنين من توابعها.
ـ وهكذا يتضح لنا تهاوي هذا السبب وبالتالي عدم صلاحيته لأن يكون منطلقاً في دراسة أزمة البرامكة.
ـ حيث يبقى بعد ذلك السبب الذي يمكن أن يوصف بالحقيقي.. ألا وهو السبب السياسي والذي يمكن تحديده بأنّه بعد مضي سنوات تبيّن للرشيد أنّ البرامكة أصبحوا يشكلون خطراً حقيقياً على دولته.
ولم يسجل التاريخ على البرامكة تعاطفهم مع العلويين أعداء الدولة العباسية فحسب، بل سجّل عليهم أيضاً ميولهم القومية مع عنصرهم الفارسي وهذا كان يتم بالضرورة على حساب العناصر العربية في دولة الرشيد.
ويمكن الباحث أن يحشد العديد من التصرُّفات التي دوّنها المؤرخون عن البرامكة كلّها تؤكد أنّ البرامكة قد استبدوا بدولة الرشيد، وأنّ نصيبهم في التحكم في هذه الدولة قد فاق بكثير نصيب الرشيد حتى إنّه قيل إنّ الرشيد يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه، في الوقت الذي كان فيه البرامكة يبذخون في الأموال بذخاً حتى إنّ جعفر بن يحيى ابتنى بيتاً كلفه عشرين مليون درهم، وكانت جائزة الفضل بن يحيى لأحد الشعراء الذين امتدحوه مائة ألف درهم مع الخِلَع.
والواقع أنّ هناك أسباباً كثيرة تجمعت وأدت إلى هذه النكبة. وتكاد هذه الأسباب تنحصر في كلمة واحدة هي ازدياد نفوذهم واستئثارهم بالسلطان حتى أصبح الخليفة وكأنّه تابع لهم. ولقد جاوزوا الحدود في سلطانهم حتى إنّ جعفر بن يحيى البرمكي أطلق سراح يحيى بن عبدالله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب وكان من الخارجين على الدولة العباسية، ولما قبض عليه دفعه الرشيد إلى جعفر ليتولى أمر حبسه واعتقاله في داره. وكان ذلك دليلاً على ثقة الرشيد بجعفر؛ ولكن جعفر في نشوة من الغرور أطلق سراح هذا الثائر العلوي دون أخذ رأي الرشيد، ولما علم الرشيد أسرها في نفسه وأخذ يدبّر لهذه النكبة حتى نفذها وأحكم تنفيذها، وتمكّن الرشيد بذلك من استرجاع سلطانه وهيبته، واستعادة زمام الملك في يديه.
أمّا تزوير الوثائق التاريخية فله أسباب عدة، فهي أحياناً تستغل من أجل تثبيت ادّعاء أو لقب باطل. ومن الأمثلة البارزة على هذا (هبة قسطنطين)، التي كان يستشهد بها في المناسبات لتدعيم النظرية القائلة بأنّ البابوات لهم حقوق إقليمية واسعة في الغرب. وفي سنة 1440م برهن لورنزو فالا مستعيناً استعانة كبيرة بالأخطاء التاريخية التي تقع في تسلسل الحوادث عن واقع للأسلوب والإشارات، أنّها كانت هبة مزورة.
نخرج من ذلك بالنتيجة التي نريدها وهي أنّ الكذب في التاريخ يرجع إلى أسباب كثيرة أهمها الغفلة وعدم الإحاطة فيما يلزم للمؤرخ من العلوم والمعارف التي تساعده على تقصي الحقائق والغوص وراءها في كلّ مظانها.
وهذا الأمر تبدو صحّته واضحة في الأساطير الشعبية، وإنّ قصص (وليم تل) بطل حرب الاستقلال السويسرية الخرافي، و(الدكتور فاوستوس)، عرّاف القرن السادس عشر، مَثَلان طيبان على الأساطير الشعبية، التي يمكن أن تنبّئنا بالكثير عن آمال الناس الذين تطوّرت بينهم هذه القصص وعن خرافاتهم وعاداتهم شريطة أن يكون المؤرخ (أو دارس الأساطير الشعبية) قادراً على التمييز بين النسيج الخرافي والأُسس الصحيحة في هذه القصص.
وكذلك فإنّ للأناشيد الشعبية الأسطورية، أهمية تاريخية مماثلة. ربما يكون صحيحاً أن (الجزّار، والخبّاز، وصانع الشموع)، قد كانوا أعضاء في أهم نقابات انكلترا في العصور الوسطى، وإنّ جاك هورنو الصغير كان أحد نُبلاء بلاط الملك هنري الثامن، الشغوفين بالاستيلاء على الأراضي، غير أنّ كاتب الأساطير الشعبية الذي يكتشف مثل هذه الأمور يستفيد من معرفته بالتاريخ أكثر مما يفيد المؤرخ.
وأحياناً تكتب وثائق حقيقية لتضليل أشخاص معاصرين بأعيانهم، ومن هنا يضلل بعض المؤرخين اللاحقين، وقد ضللت عبارة افترض فيها أنّ قائلها هو الإمبراطور (ليوبولد الثاني)، وتبيّن وجهة نظره في الثورة الفرنسية، ضللت ماري إنطوانيت، وبالتالي معظم المؤرخين المدققين، حتى انكشف أمرها في سنة 1894م.
وبين الحين والحين ينجم تشويه طبيعة الكُتُب المطبوعة من جرّاء حيل المحققين وما زال السؤال قائماً حول أي من الكتابات الكثيرة المعزوة إلى الكاردينال (ريشليو) أكَتَبها هو بنفسه أو أملاها؟ وكذلك الحال في ما يُسمى مذكرات جان دويت ووثيقة كولبير السياسية، فإنّ جزءاً صغيراً منهما كتبه جان دويت، كولبيير. على أنّ المذكرات المعزوة إلى (كوندورسيه) وويير أخي ماري انطوانيت بالرضاعة، وعديداً من المؤلفات المعزوة إلى (نابليون الأوّل)، هي من وضع أُناس غيرهم، ولاريب في أنّ بعض أعداد الجرائد اليومية، وضعت قبل تواريخها التي تحملها بمدة طويلة، وأعداد جريدة (المونيتور) تعطينا بعض الأمثلة الطيِّبة على ذلك، وإنّ العديد من مذكرات نابليون اليومية قد ألفّها أُناس كثيرون من واقع كتاباته.
على أنّ ظروف تزييف الحقائق التاريخية في حدِّ ذاتها أو تشويهها قد تكشف في أحيان كثيرة عن معلومات سياسية وثقافية سرية هامة، وهذه الكشوف لا تثور حول نفس الحوادث والأشخاص، كما لو أنّ هذه الوثائق المزورة كانت في واقعها حقيقية لا زيف فيها.
إنّ الوثيقة التي تجيء مزورة في جملتها أو في جزء كبير منها نتيجة جهد متعمد، لكي تضلل وتخدع، كثيراً ما يكون من الصعب أن نزنها ونبيّن قيمتها؛ ولكنّها أحياناً تسبب إشكالاً أقل مما تسببه وثيقة غير موثوق في جزء بسيط منها فحسب، لأنّ مثل هذه الأجزاء تنتج في الغالب عن خطأ غير متعمد، لا عن تزوير مدروس. ومثل هذه الوثائق نجدها غالباً في نسخ لوثائق اختفت أصولها، وهي تتسبب عموماً عن ذلك النوع من الخطأ الناتج عن الحذف، أو التكرار، أو الزيادة، وهي أمور يعتادها أي شخص قام بإعداد مثل تلك النسخ بنفسه. وهي قد تنجم كذلك عن قصد متعمد في التبسيط والإضافة وتكملة الوثيقة الأصلية لا عن الإهمال، ومثل هذا التبديل قد يتم عن حُسن نية في المرة الأولى عندما يتوجه الانتباه إلى التدليل على الفروض بين النص الأصلي والقواميس الملحقة بالنص لشرح المفردات الصعبة أو الذيول، غير أنّ الناسخين اللاحقين لا يهتمون الاهتمام اللازم بالتنبيه إلى مثل تلك الفروق.
ولكي يميِّز المؤرخ الوثيقة الأصلية من الوثيقة المزيفة أو المحرفة، يجب عليه أن يستخدم الاختبارات المتبعة في مثل هذا الأمر في التحري البوليسي والقضائي. فبعد أن يصل إلى أفضل تخمين عن تاريخ الوثيقة يختبر المواد الكتابية ليرى في ما إذا كانت متأخرة عن التاريخ الذي ترجع إليه الوثيقة. فالورق كان نادراً في أوروبا في القرن الخامس عشر، والطباعة كانت مجهولة آنذاك، وأمّا أقلام الرصاص فلم يكن لها وجود هناك قبل القرن السادس عشر، وأمّا الطباعة على الآلة الكاتبة فلم تخترع إلّا في القرن التاسع عشر ولم يصل ورق الهند إلّا في نهاية ذلك القرن، وكذلك يفحص المؤرخ الحبر بحثاً عن العلامات التي تحدد عمره أوّلاً باحثاً عن تركيب كيماوي يثبت أنّه متأخر عن تاريخ الوثيقة، وبعد أن يبذل جهده في معرفة مؤلف الوثيقة يتدبر في ما إذا كان بمقدوره أن يتحقق من الخطّ والتوقيع والخاتم وأصل الورق أو العلامة المائية المميزة في الورق. وحتى عندما تتكون الكتابة غير مألوفة للمرء، فإنّه يمكن مقارنتها بعينات موثوق في صحّتها. ويمكن الرجوع في هذه الحالة إلى ما يسميه الفرنسيون ايسوغرافي Isographies أي قواميس السِّير التي تدنّ عينات من خطّ يد كلّ مؤلف مشهور.►
المصدر: كتاب المسلمون وكتابة التاريخ
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق