- ١٦ كانون ثاني/يناير ٢٠٢٥ | ١٦ رجب ١٤٤٦ هـ
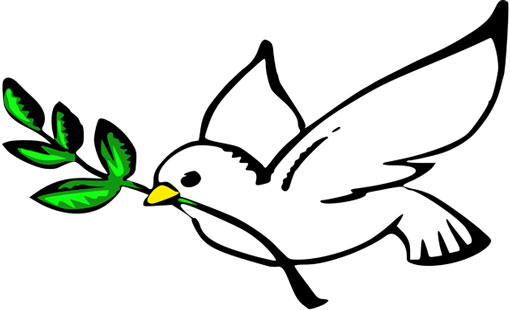
◄يُسجِّل أحد الباحثين على نظرية السلم الدائم المبني على العقل، بمفهومه الليبرالي النفعي، إغفالها العنف الذي مورس على الأقليات وعلى الشعوب التي استعمرت واستغلت أو تمّ القضاء عليها جزئياً أو كلياً (بدءاً من المجتمعات الأمريكية قبل الغزو الأوروبي)، واحتلالها أكبر جزء من المعمورة إلى غاية الخمسينات والستينات من القرن العشرين. كما أنّها أغفلت النظريات التي غذّت هذه الوضعية أو التي تغذّت منها. لذا علينا - كما يقول - إدراك درجة الحذر المطلوب من مثل هذا الطرح، وخاصّة أنّه مورس باسم دعوى استتباب السلم ونشر الحضارة في العالم، وكلّ ذلك، مقروناً بنشر مثاليات دينية مسيحية، سيما وأنّ المنظومة الغازية كانت ولاتزال هي المنظومة الوطنية المتمثلة في نظام الدولة الليبرالية، عنوان ما يُسمّى بالحضارة والرقي.
فإذا - كما يؤكد - لابدّ من الحذر في التعامل مع كلّ من أطروحة السلم الدائم حسب ما تدّعيه الليبرالية، وأطروحة العدل التام تحت ظل المساواة التامّة، فمع هاتين الأطروحتين يتم إدخال المطلقات في السياسة؛ كما أنّ ما تُسمِّيه بعض التيارات بـ(النظام الإسلامي) أو (المنهج النبويّ) يدخل، هو أيضاً، مطلقات دينية في صميم الممارسات السياسية، وهذا خطر على المجتمعات، إذ أنّه يفتح باباً لتفشي العنف بدل الحدّ منه، ويسد باب الرّفق والتمرّن والتمرين على الحوار والاتفاق في ظل السلم النسبي، والقدرة على تنظيم العيش في أُفق الدنيا. علماً بأنّ التشبث بالمطلقات في أُمور العقيدة والدِّين شيء بديهي ومسلم به، ويستوجب التعامل معه بالاحترام من قبل الجميع، كيفما كانت درجة الاختلاف بين المذاهب والعقائد.
لكن تلك المؤاخذات التي سجلها الباحث لا تعني ذاتية العنف بالنسبة إلى الإنسان أو عدم إمكان الحدّ منه وتحجيمه ووضعه في دائرة السيطرة التي تتحكّم بها القيم الأخلاقية والدينية، وهو أمر ممكن وليس مستحيلاً، رغم اتساع رقعة العنف والتصاقه بالإنسان منذ فجر التاريخ، بل من الممكن اللجوء إلى القوّة، باعتبارها مفهوماً آخر يغاير العنف، لمحاصرة العنف. كما يمكن من خلال مقاربة الأسباب الأخرى وفهم علاقتها بالعنف السيطرة على العنف نفسه. وليس اللجوء إلى القوّة هروباً من العنف إلى عنف أشد وأقسى متشحاً بمفاهيم أخرى، وإنّما إيماناً بوجود ضرورة لممارسة العنف، كما في العنف المضاد، أو لحماية أمن البلاد والمجتمع من اجتياح العنف. أي إنّ القوّة وإن كانت تستبطن العنف - مهما حاولنا تبرير ذلك - إلّا أنّها ممارسة مشروعة إمّا شرعاً، إذا كانت تتوافر على دليل شرعي أو من خلال المصادقة المشروعة وليست المستبدة على القوانين، كما بالنسبة لقوانين ومقررات الدول المنتخبة مباشرة من قبل الشعب أو المخولة شرعاً بسن القوانين. وهذا لا يشمل قرارات الدول لشن الحروب على دول وشعوب أخرى أو استعمار بلدانها، لأنّها تدخل ضمن مفهوم الإرهاب وليس العنف فقط لاقترافها ممارسات عدوانية تطال الإنسان ومقدراته وممتلكاته وتهدر كرامته وتصادر حرّيته مهما كانت المبررات، إلّا إذا استنجد شعب بدولة ما، وهو أمر نادر، لتحريره من أسر الدكتاتورية والاسبتداد وتخليصه من ظلم يعتقد إنّه أهون من الاحتلال الأجنبي، أو إنّه سينال هامش من الحرّية تهون معه التضحيات الكبيرة فيكون الشعب هو المسؤول عن تداعيات تلك العملية وما يرافقها من ممارسات عنيفة، وهذه مسألة أخرى.
وحينما نعود إلى مفهوم السلم، نجد ثمة ما يُعزِّز الشكوك المتقدّمة حول صدقيته، إذ ليس السلم هو مطلق اختفاء العنف، وإنّما هو أحد الأسباب الموجبة لذلك، وربّما يعود السبب في تواري مظاهر العنف داخل المجتمع إلى أسباب أخرى مثل سطوة السلطة وقدرتها على ضبط الأمن إلى درجة تختفي معها جميع مظاهر العنف خوفاً ورعباً، لا إيماناً به. أو أن يعكس السلم تكتيكاً سياسياً، أو ظرفاً طارئاً يضغط باتّجاه تأجيل ممارسة العنف حتى حين، أو صرامة الوسط الاجتماعي الذي يعيش الفرد داخله. وكلّ هذه المظاهر لا تُعبِّر عن وجود سلم حقيقي واستجابة صادقة، لأنّ السلم فيها لم ينطلق من موقف اختياري لأفراد الشعب، ولا يعكس رؤية معرفية تعي السلم وضروراته وترفض العنف وتداعياته رغم قدرته عليه.
وإنّما السلم في هذه الحالات استجابة لظروف ضاغطة، ومحاولة لتأجيل العنف حتى إشعار آخر، والعودة إليه ثانية بعد زوال مبررات الإحجام عنه. كما في حالة طالب المدرسة العنيف والمشاغب، الذي يلجأ للعنف فور غياب مُعلِّمه أو المشرف التربوي، وكذا أفراد العائلة الذين يعيشون تحت سلطة أب دكتاتور مستبد يخشى الجميع سطوته وبطشه، فإنّ سلوكهم لا يُمثِّل روح السلم التي نتحدّث عنها.
وفي هذه الحالات وغيرها، لا يصح أن نحكم على هذه البيئات بأنّها بيئات مسالمة ترفض العنف وتتمسّك باللاعنف في حياتها، وإنّما ثمة ظروف استثنائية فرضت السلم عليها، وليست هي السلم، لأنّ السلم عقل ومنهج وسلوك، وليس موقفاً يملأه الخوف والرُّعب. عقل يتوفّر على قناعات معرفية تجعله يعتمد السلم منهجاً في الحياة وسلوكاً يومياً يتجلّى في أفعاله وتصرّفاته.
من هنا يعرّف (اسبينوزا) السلم قائلاً: "السلم يعني: القدرة على التوصل إلى غياب المعارك والعنف والصراع انطلاقاً من القدرة العاقلة في الإنسان والمعرفة المنتشرة في الجميع"، ويضيف موضحاً: "إذا كان الناس في مجتمع ما لا يحملون السلاح، أو لا يلجأون إلى السلاح لأنّهم يعيشون تحت وطأة الرُّعب، فيجب أن نقول إنّ السلم لا يسود في هذا المجتمع، بل يتعلّق الأمر فقط بغياب الحرب. إنّ السلم ليس مجرد غياب للحرب، إنّها فضيلة تجد أصلها في قوّة النفس أو الروح، لأنّ الامتثال إرادة مستديمة لدى الناس للقيام بما يجب القيام به، تبعاً لقانون ذلك المجتمع. إنّ مجتمعنا تكوّن فيه السلم نتيجة لجمود الناس وتقاعسهم، ويقتاد أُناسه كالقطيع، لأنّه لم يتم إعدادهم سوى للطاعة، مجتمع كهذا لا يمكن أن يُسمّى مجتمعاً، بل عزلة".
ويرى أيضاً: "إنّ السلم ليس هو مجرد غياب الحرب أو انعدامها، بل إنّ السلم أكثر من ذلك. فجمود الناس، هنا وهناك، وتقاعسهم أو خوفهم أو وقوعهم تحت تأثير الرُّعب يجعلهم خاضعين أو متظاهرين بالخضوع والعيش في السكينة. إنّ هذا الخضوع، أو التظاهر بالخضوع، هو ما قد يُفسِّر اللجوء المفاجئ لأشكال قاسية من العنف، ذلك أنّ الناس هؤلاء الذين يطيعون أو يتظاهرون بالطاعة لم يتم إعدادهم إلّا لذلك، لقد تمّ "تطويعهم" بوسائل شتّى منها الرُّعب، والخوف، والمس بمصالحهم، ومنها أساليب قد يغيب عنها الرُّعب في الظاهر، ويبقى في الخفاء يحرسها، كما نجده في وسائل التربية والحياة العائلية والسلوكية اليومية. إنّ أُناساً لم يتعوّدوا إلّا على الطاعة، قد يطيعون فعلاً، وقد يمكرون. وفي كلّ الحالات، فهم يخضعون لأي جهة ولأي قوّة تستبد بهم. وهذا أمر يخالف حالة السلم الحقيقية".
إذن حالة السلم وفقاً لهذا الرأي تتميّز بوجود دافع ذاتي يدفع الناس للقيام بواجباتهم، استجابة لما تمليه شروط الحياة الجماعية والفردية. فيصدر العمل بمحض إرادتهم، وليس خوفاً من أيّة جهة كانت، وإنّما يحترم أفراد المجتمع القوانين والأوامر والقرارات التي يعمل بها في مجتمعهم حفاظاً على أنفسهم ومصالحهم، ويقصدون نفس الشيء بالنسبة للآخرين، انطلاقاً من إيمان راسخ بضرورة عملهم، وليس هناك إكراه يدعو للتحايل والمكر. بينما مَن لا يحترم القوانين إلّا مكرهاً، قد يتحايل عليها، وقد ينجح في التحايل على القانون، وهذا منتشر جدّاً.
"فمجتمع الخضوع والمخادعة ليس بمجتمع يسود فيه السلم لمجرد انعدام الحرب، بل ليس هو بتاتاً مجتمع في نظر (اسبينوزا)، لأنّ الناس يعيشون في عزلة. فخوفهم من الآخرين، وربّما خوفهم من أنفسهم، يجعل رغبتهم في التعايش الفعلي والإيجابي ضعيفة، فيسود الاضطراب والارتياب والانطواء والاحتياط المبالغ فيه والزائد عن الحدّ. فيسود في المجتمع اللجوء إلى المكر والضغينة، إمّا حفاظاً على الذات، وإمّا لاتقاء شرّ الآخرين وضررهم".
تأسيساً على ما تقدّم، يمكن التمييز بين السلم الحقيقي والسلم التكتيكي المصطنع. فالأوّل يصدر عن قناعة واختيار وإرادة، والثاني يُعبِّر عن إكراه واضطرار وحيلة ومكر، لذا يتباين سلوكهما من حيث الثبات والصدق. وكما أنّ الأوّل يواصل مسيرته في تبنّي السلم مبدأ في الحياة، سلوكاً وعملاً، فإنّ الثاني قد يفاجئ المجتمع بعنف يصل حدّ الإرهاب، ليُعبِّر عن كبت القيم ورفض سلطة الأعراف والتقاليد الاجتماعية، فيثور في أوّل سانحة منقلباً إلى وحش ضار، عنيف في تصرّفاته وسلوكه. وهنا يأتي دور العقل ليُحدِّد اتّجاه السلم ويعلن عن هُويّته فيكون بوصلة أمان لمن وثق به واتّخذه مرجعية لسلوكه وتصرّفاته، إلّا أنّ المشكلة في عدم استفادة الناس من قدراتهم العقلية والتخلي عن مرجعيته في مسألة الخلافات والصراعات، لينساقوا وراء قيم أخرى تتقاطع معه وترفض سلطته.
وبهذا الخصوص يؤكد (سبينوزا): "أنّ استعمال الناس لقدراتهم ومَلَكاتهم العقلية التي تستطيع أن تسير سلوكياتهم بشكل سليم، مسألة شديدة الوضوح، فقليلاً ما يلجأ الناس إلى الاستفادة من هذه المَلَكات أكانت موزّعة بشكل عادل بينهم أم لا؟ فيقول: نادراً ما يعيش الناس حياتهم تحت إمرة العقل، فأكثرهم يحسدون ولا يحتملون بعضهم البعض، لكنّهم لا يستطيعون أن يحيوا حياتهم في عزلة، لدرجة أنّ معظمهم يتلذذون بالتعريف القائل إنّ الإنسان حيوان سياسي".
وعندما نتكلّم عن قيم العقل، نقصد ما يشمل القيم الدينية والإنسانية، لأنّ الدِّين، كلّ دين، يرفض العنف ويشجب الممارسات العدوانية، ويبغض الحروب القائمة على ذلك. أي إنّ العنف ينتمي، إلى منظومة قيم أخرى لا تمت إلى الدِّين والعقل بصلة. فالقرآن الكريم يبارك السلم ويؤكده في موازاة اهتمامه بموضوع الجهاد وقتال الأعداء. لكن الثاني ليس مبدأ، وإنّما مرحلة فرضتها الضرورة وظروف الدعوة.
وأمّا السلم، فإنّه مبدأ إسلامي تعكسه صراحة بعض الآيات، مثل (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الأنفال/ 61). ويستفاد أيضاً من مصفوفة الآيات الأخلاقية، في سورة الحجرات، التي عمدت إلى تجفيف منابع العنف وإغلاق أكثر منافذه، للحيلولة دون تدفق مواد أوّلية صالحة لصناعة العنف مهما صغرت، كالغيبة والنميمة والفحش بالقول والكذب والافتراء والسباب والتنابز بالألقاب والتدخل في شؤون الغير والإكراه والاحتقار والإهمال المتعمد بما في ذلك إهمال رد السلام و...
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات/ 11).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) (الحجرات/ 12).
وهذا يؤكِّد إنّ السلم ليس موضوعاً طارئاً أو إنّه يتوقف على إعلان السلم من قبل الطرف الآخر باعتباره يختص بمسألة الحرب، لأنّ بواعث العنف لا تقتصر عليه، وإنّما أسبابه كثيرة، والجانب الأخلاقي يُمثِّل الجانب الأهم فيها، إذ منشأ كثير من ردود الفعل التي تجر إلى العنف مواقف أخلاقية. فمثلاً ردّ التحية التي يؤكِّد عليها القرآن الكريم (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) (النساء/ 86) باعتبار إنّ إشاعة السلام تبني للسلم والمسالمة ورفض الاعتداء، فهو أكثر من تحية مجردة تفرضها قيم المجتمع، بل هو رفع لشعار السلم وتأكيده في كلّ مناسبة مع أي شخص أو جماعة، ففي كلّ مرّة يلقي الإنسان التحية يؤكِّد فيها تمسكه بالسلم ولو على مستوى الشعار، على أمل أن يتجسّد إلى سلوك راسخ في النفس.
ثمّ من زاوية أخرى إنّ عدم ردّ التحية أو التراخي واللامبالاة في ردّها تعكس موقفاً سلبياً، أو هكذا يفهمه المتلقي في إطار قيم المجتمع وعادته، وعدم الرد يستفز الإنسان ويُولّد لديه شعور بالخيبة ويكون بمثابة صفعة قوية لكرامته وحيثيته، تطعن بشخصيته فيثأر لها من خلال العنف إذا تخلّى عن تحكيم العقل سريعاً. إذن التأكيد على ردّ التحية، وهو مجرّد مثال ضمن منظومة القيم القرآنية، يضع حدّاً لممارسة العنف من هذه الجهة، ممّا يؤكِّد أنّ السلام مبدأ في الإسلام. وثمة أمثلة أخرى يمكن استدعاؤها لتأكيد أهميّة السلم في القرآن الكريم وتبنّي الإسلام له مبدأ أساسياً يرفض التنازل عنه أو التفريط به لأي سبب كان، بل إنّ تسمية هذا الدِّين بالإسلام التي هي من اشتقاقات السلم يكفي لتأكيده.
- سيكولوجيا العنف:
غالباً ما يصدر العنف عن قناعات فكرية وعقدية تشرعن ممارساته التي قد تصل حدّ الإرهاب في أحيان كثيرة. وليس بالضرورة أن تكون تلك المسلّمات والقناعات خاضعة لمنطلق العقل، بل إنّ بصمات الخطاب الأيديولوجي أكثر تجلّياً ووضوحاً في الفعل الإرهابي. وإمّا هنا، فيكرّس البحث لتقصي سيكولوجيا العنف، وما يسبقه أو يرافقه من حالات نفسية، لأنّ العنف، بجميع أشكاله، من هذه الزاوية تأزُّم وانفعال وتوتّر يسبق أو يرافق الفعل.
تارة يكون العنف فعلاً يمارسه شخص ضد آخر لسبب ما، فيعنّفه، يقرِّعه، يوبِّخه، يؤنِّبه، يشتمه، يضربه، يضطهده، يجرحه، وربّما يقتله. وأخرى يكون العنف رد فعل يضطره للثأر لنفسه وكرامته، فيمارس عنفاً مماثلاً أو أشد قوّة وآثاراً. وفي كلا الحالتين يخضع المرء لحالة نفسية تختلف عنها عندما يكون في وضع اعتيادي. حتى وإن مارس العنف بقدر كبير من اللامبالاة وبرودة الأعصاب، ومثاله المجرمون وأرباب السوابق ممّن أدمنوا ارتكاب الجرائم. وتبدأ الحالة الجديدة بموجة محفزات شعورية أو لا شعورية حول قضية ما، ثمّ تتفاعل بتصوّرات وأحكام وقيم سابقة أو تتكوّن فوراً لتتأزّم الحالة وتتحوّل إلى توتر نفسي تصحبه موجة عصبية تستولي على مشاعر الشخص، ثمّ يقفز إلى الخارج عبر حالات مختلفة: كارتعاش الجسم أو توتر وحدة في الكلام، أو صدور ألفاظ جارحة ونابية، أو صدور فعل جسمي وعضلي يترك أثراً في جسد الشخص المقابل. سواء كان الموجب للعنف عقدة أو مرضاً نفسياً، أو تأكيداً للذات، أو لتحقيق هدف ما، أو لأي سبب أو داع آخر كان.
وعندما يتعرّض الإنسان للعنف بشكل يمس كرامته وحيثيته ومكانته ووجوده وشخصيته وشرفه أو شيئاً من حقوقه وربّما عقيدته ودينه، أو يصاب بخيبة أمل أو إحباط وعدم تفاؤل بالحاضر فضلاً عن المستقبل، تتفاعل معه النفس البشرية إلى درجة تكتسي الكرامة والشرف والحقّ الشخصي أو الجماعي قيمة مطلقة تهون معها التضحيات، أو ينتهي إلى قناعة متسرِّعة في ظل التأزُّم النفسي، يعتقد معها بالعنف طريقاً وحيداً لتسوية الأمور وردّ الاعتبار، كما في حالات ردّ الفعل.
أمّا لماذا لا يستجيب الإنسان لنداء العقل وقيم الدِّين والأخلاق ويمارس العنف بشكل رتيب ويومي؟
المؤكّد أنّ استجابة الإنسان لمشاعره وعواطفه أكثر وأسرع من استجابته لعقله. وليس الإنسان عقلاً خالصاً، ولا مشاعر مجردة وإنّما هو مزيج من العقل والمشاعر، غير أنّ النفس تتفاعل وتستجيب للمشاعر لقوّة تأثيرها بسبب سلاستها وبساطتها وشدّة التصاقها بها، بعكس العقل الذي تتطلب آراؤه قدراً كبيراً من التأمُّل والنظر والوعي واليقظة كي يعي الإنسان أحكامه. أي إنّ القضايا العاطفية تمارس سلطتها على المشاعر والأحاسيس التي تحيط الإنسان من كلّ زاوية، مع تعدّد نوافذها على الحياة، وتفرض عليها التفاعل معها، والاستجابة لتأثيراتها، فترى الاستجابة فورية، لأنّ النفس في تركيبها ليست سوى مزيج من العواطف والأحاسيس والمشاعر التي تقتات على إمدادات الحواس الخمسة، لتتفاعل مع كلّ وافد ومن ثمّ تتخذ موقفاً منه في ضوء تراكمات قبلية، لتبدو على الإنسان مظاهر الحبّ والبغض، العاطفة والحنان، الودّ والكره، وغير ذلك من المواقف العاطفية.
فالنفس أشبه ما تكون بالألواح فائقة الحساسية التي تتأثر بسرعة كبيرة عندما تواجه حزمة ضوئية، وهي الألواح المستعملة عادة في الصور الفوتوغرافية. وتقتصر وظيفة العقل حينئذ بمد الجانب النفسي بتصوّرات ومتخيلات تشتمل على مزيج من المشاعر النفسية والتصوّرات والأحكام العقلية. فتتفاعل النفس بما يشبع حاجتها من الجانب العاطفي، لكن ليس بالضرورة أن تتفاعل مع أحكام العقل، وقد تستجيب لها وتضبط مشاعرها، كما إنّ أحكام العقل ليست أقوى تأثيراً، لأنّها عقل، إلّا قليلاً.
ولكلّ شخص أيضاً تصوّرات متراكمة عن ذاته، تكون المسؤول الأوّل عن تشكيل أبعاد شخصيته كما هو يعيها. فهو لا شعورياً لا يعي سوى المركب أو الصورة التي أنتجها، وعلى أساسها يمارس دوره الاجتماعي ويتخذ مواقفه. وليس بالضرورة أن تكون جميع القضايا صادقة ومطابقة للواقع، بل ربّما تكون نسبة لا بأس بها أوهاماً ينسجها الشخص عن نفسه ومقامه الاجتماعي ومستواه الثقافي.
وبمرور الأيام والتأكيد المستمر عليها، تنقلب الأوهام إلى حقائق لا يطيق الاعتراف بخطأها، ثمّ تأخذ الذات بالانتفاخ والتضخم إلى حدّ يفترض هو لنفسه مواقع اجتماعية ومكانة علمية، مجردة عن أي رصيد حقيقي. فمثلاً لا يجلس إلّا في مكان يتناسب مع مكانته الاجتماعية التي وضع نفسه بها عندما يرود المجالس التي تعتني بالرُّتب الاجتماعية، وإذا اضطرّ لأيّ سبب للجلوس في مجلس أدنى تثور حفيظته لا شعورياً، بسبب الإرباك الذي طرأ على هندسة شخصيته، والخلل الذي باغت شخصيته الوهمية. فتعكس ردة الفعل حجم الضرر النفسي الذي لحق به. وقد تسبّبت هذه المسائل في وقوع كثير من أعمال العنف في المناطق التي تقطنها مجتمعات بدوية تعبر فيها الأمور عن مستوى شخصياتهم.
لهذا عندما يواجه المرء عملاً إرهابياً أو عنفاً أو تحديات خطيرة تتأجج عواطفه ثمّ سرعان ما تتأزّم الحالة النفسية له وتنقلب إلى توتر لا يطيق الانحباس والسجن داخل النفس، وهي حالات لا إرادية تعصف بالإنسان، لهذا كان التعبير القرآني في أوج البلاغة والدقة عندما وصف المؤمنين بـ(الكاظمين الغيط)، فالغيط هو التوتر النفسي الذي يسبق الفعل بشكل لا إرادي، لذا لم ينهَ القرآن عنه، لأنّه خارج عن إرادة الإنسان ويمس المشاعر والأحاسيس مباشرة، وتظهر آثاره النفسية فوراً، لكن يمكن السيطرة عليه وحبسه وتكبيله قبل انقلابه إلى عمل عنيف، من هنا دعاهم القرآن إلى كظمه.
وقد اعتبر القرآن كظم الغيط والعفو بمثابة الإحسان، لقوّة الآثار المترتبة عليه، إذ ربّما موقف مماثل ينقذ إنسان أو أُمّة من الناس من موت محتم، أو فتنة خطيرة تقضي على مظاهر الحياة، قال تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران/ 33–34).
والحقيقة إنّ كظم الغيظ ليس أمراً ميسوراً لكلّ إنسان، سيما إذا أدّت الحادثة التي يواجهها إلى انهيار مشروع كان يعول عليه، أو تحطمت آمال طالما راودت أحلامه، أو تسبّبت الحادثة في انتهاك حرمة من حرماته. وقد غضب موسى (ع) وهو نبيّ مرسل، عندما اتخذ قومه من بعده عجلاً يعبدونه من دون الله، ولشدة غضبه أخذ برأس أخيه وهو في حالة من التوتر والغيظ، لأنّه شعر بانهيار مشروعه الرسالي الذي بذل من أجله عملاً طويلاً من الدعوة والتضحية، بل ولم يصغ موسى - وهو في حالة ثورة - إلى نداء العقل إلّا بعد حين، بعد أن كلّمه أخوه بإناة وهدوء، حينئذ فقط طلب من الله المغفرة له ولأخيه، وعاد ليواصل دعوته مع قومه: (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأعراف/ 150).
ثمة قضية أخرى، لما كان مقرراً عندهم إنّ الإنسان اجتماعي بالطبع، فإنّ معنى اجتماعيته إنّه لا يستطيع العيش إلّا ضمن جماعة يؤثر ويتأثر بهم. ولكلّ جماعة قيم وأعراف خاصّة، بها تضبط حركة أفرادها، وتسوقهم باتجاه يعكس إرادتها الجماعية. وبالتالي، فإنّ كلّ فرد ضمن الجماعة يستمد منها حزمة كبيرة من القيم يغذي بها منظومته القيمية، حتى يصل مرحلة من التفاعل داخل بيئة الجماعة تتوحّد فيها جميع القيم، بل تكون قيمته من قيمة المجموع أو قيمة الكيان الذي ينتمي له، فيستجيب بشكل لا إرادي لقيم المجموعة التي انغرست لا شعورياً في لا وعيه لتكون سلطة فوقية تلعب دوراً كبيراً في توجيه سلوكه، فيكون حرباً لمن حاربهم وسلماً لمن سالمهم، يغضب لغضبهم، ولا يتردّد في أي عمل من أجل ردّ الاعتبار لهم وتمكينهم من استرجاع حقوقهم.
وفي البيت الشعري الآتي تجسيد حي لهذه الرؤية، يقول الشاعر:
ما أنا إلّا من غزية إن غوت*****غويت وأن ترشد غزية أرشد
وإضافة إلى القيم الشخصية والاجتماعية والدينية والأخلاقية التي توجّه سلوك الإنسان وتدفعه باتّجاه العنف أو السلم، هناك عوامل سيكولوجية تمارس سلطتها عليه، وكثيراً ما تعود أسبابها إلى مرض عضوي، ويضرب لذلك المتخصصون بالطب النفسي مرض الصرع، اضطراب الدورة الشهرية لدى النساء، الأمراض المعوية، وأيضاً "السلوك الانفجاري لدى مرضى الصرع ونوبات الهياج الفصامي وبعض الاضطرابات الكروموزومية وخصوصاً تعدُّد كروموزومات الذكورة. كما بيّنت أبحاث الهندسة الوراثية عدّة تشوّهات كروموزومية متصاحبة مع مظاهر السلوك العدواني. ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ وجود هذه الاضطرابات لا يعني ضرورة ظهور المظاهر العدوانية، فهناك حاملين لها دون مظاهر".
ويُصنِّف الطب النفسي حالات العنف إلى:
1- حالات عنف صريحة، وتشمل:
- عنف جسدي (كدمات، رضوض، تكسير... إلخ).
- عنف معنوي (كلامي، شتائم... إلخ).
- سلوك هجاني مصاحب للأذى.
- مواقف سلبية مؤذية (رفض الطعام أو الكلام).
2- حالات عنف مستترة، وتقسّم إلى:
- عنف مستتر بمحاولات السخرية والتحقير.
- عنف مستتر بمحاولات الحماية.
- عنف مستتر يصعب استشفافه ويظهر فجأة.
ويقول الطبيب النفسي د. محمّد أحمد النابلسي: صحيح أنّ احتمال ارتكاب أعمال العنف يرتفع عند المرضى النفسيين، لكن هذا الارتفاع لا يصل إلى درجة خوف الجمهور من هؤلاء المرضى. ولدى هؤلاء أيضاً نلاحظ تقسيماً سيكاترياً لحالات العنف، هي حسب رأينا:
أ) حالات عنف صريحة:
- الرغبة في الشجار والعراك الجسدي.
- هوس المحاكم (يميل مرضى البارانويا إلى رفع الدعاوى القضائية لأتفه الأسباب).
- محاولات إيذاء الذات.
- محاولات إيذاء الآخرين.
ب) حالات عنف مستترة:
- اتهامات هذيانية موجّهة للمحيط والمتعاملين مع المريض.
- رفض الفحص والعلاج (عدوانية تجاه المعالج).
- محاولات السخرية والتحقير.
ج) حالات عنف متوقعة في الأمراض التالية:
- السلوك الصرعي الانفجاري (إيذاء الذات والغير).
- النوبات الفصامية الحادة (إيذاء الذات والغير).
- النوبات الاكتئابية (إيذاء الذات غالباً).
- اضطرابات الشخصية الحادة (عنف معنوي غالباً).
ومهما كانت الأسباب والمنطلقات النفسية للعنف، فإنّ ممارسته تكشف عن خلفية فكرية، مهما كانت بسيطة وساذجة، أو إنّه يأتي امتثالاً لسلطة فوقية لا يعي تأثيراتها دائماً، وإنّما ينساق وراءها لا إرادياً في كثير من الأحيان، كما بالنسبة إلى الأعراف القبلية والتقاليد الاجتماعية التي يستجيب لها الإنسان لا إرادياً. وعلى كلّ الأحوال، عندما يمارس العنف إلى درجة الإرهاب في أي مجال من المجالات، فدلالته لا تخرج عن إحدى الحالات التالية:
1- يعتقد الممارس للعنف إنّه يمثل الشرعية القانونية أو الدينية، فيتحرّك ضمن صلاحياته القانونية أو الشرعية، ويكون من حقّه قمع الآخر واضطهاده بكلّ الوسائل المتاحة، بينما يصبح الآخر عندما يعلن قناعاته خارجاً على القانون أو الشريعة والدِّين، وبالتالي فهو يستحق كلّ ما يُفعل به.
2- يعتقد الممارس للعنف إنّه على حقّ في متبنياته الفكرية والعقدية، أو إنّه حقّ مطلقاً والآخر باطل مطلقاً، ضال، كافر، منحرف يجوز قمعه وإرهابه، بل قتله والتمثيل به أيضاً. فالاختلاف هنا، أي في وعي الممارس للعنف، ليس حالة مشروعة تقع بين جميع البشر، وإنّما ضلال وانحراف فكري أو عقدي أو ديني. وهذا يجد مصداقه الواضح في الشخص الأيديولوجي الذي لا يخضع لمنطق العقل ولا يستسيغه، وإنّما هو دائماً مقموع تحت سقف أيديولوجي لا يطيق الرأي الآخر، ويرفض مراجعة متبنياته العقدية والفكرية، فيلجأ للعنف عندما يحاصر من قبل خصمه الفكري أو السياسي.
3- للاستبداد، سواء كان سياسياً أو دينياً، فرداً أو جهة، حزباً أو حركة، دور أساس في ممارسة العنف مع الخصوم السياسيين والفكريين والدينيين، لأنّ المستبد لا يطيق الآخر، فكيف يطيق التجاهر بمخالفته؟ إنّ منطق الاستبداد يقتضي خضوع الجميع للرجل المستبد، وعدم مخالفته فكرياً أو عقدياً، بل وينحو المستبد مع الآخرين على أساس إنّه مطلق في كلّ شيء وله الحقّ في ممارسة أي شيء.
4- لا ينفك العنف عن الدكتاتورية بأي شكل، خلافاً للسلطة المستبدة التي قد تمارس العنف أو لا تمارسه، إذ تقوم حكومة الدكتاتور بتركيز جميع السلطات في شخص الدكتاتور، فتُلغى كلّ الضوابط القانونية ما عدا إرادته، أو بالأحرى إنّ القانون هو امتثال لإرادته ورغباته. من هنا نجد الدكتاتور يمارس العنف لأدنى شك أو شبه مع أي شخص أو جهة. فكلّ مَن تسول له نفسه معارضته أو التمرُّد عليه، سيكون مصيره السجن والتعذيب وربّما الإعدام، العنف بالنسبة له فعل متواصل.
5- عندما تختفي لغة الحوار، يطغى العنف وتتضاءل فرص التسوية السلمية على صعيد النزاعات السياسية والعسكرية، كما تتعمّق الخلافات على المستوى الفكري والعقدي. بينما يسود التفاهم وتضييق هوة الخلافات إذا حلت لغة الحوار وتلاشى العنف بين الأطراف المتنازعة.
6- قد يلجأ البعض إلى العنف في تحقيق أهدافه لعدم قدرته على ذلك سلمياً، أو إنّه يضطر له لانتزاع حقوقه المغتصبة.
8- قد يكون منطلق العنف أعرافاً عشائرية أو تقاليد اجتماعية تفرض عليه موقفاً عنيفاً تجاه الخصم.
8- تارة يُعبِّر العنف عن أزمة نفسية تطرأ على الإنسان لأي سبب كان، فيمارس العنف من عقدة في لا وعيه تبيح له عمله.
9- قد يعتقد الإنسان العنيف إنّ العنف أقصر الطُّرق لتحقيق أهدافه تعويلاً على قدراته العضلية وقوته وتخطيه للقوانين والأعراف وعدم اهتمامه بتداعياته.
10- قد يجد الفرد في العنف ذاته المفقودة، فيمارسه لتأكيدها، وانتشالها من واقع نفسي مرير مدمر طالما عانى منه، أو ليزيل عنها غبار الإهمال الاجتماعي والتهميش الطبقي. فيشعر عندما يمارس العنف إنّه موجود فعلاً وله استقلالية وقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها، بل وفرضها على الآخرين.►
المصدر: كتاب تحديات العنف
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق