- ٢٣ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
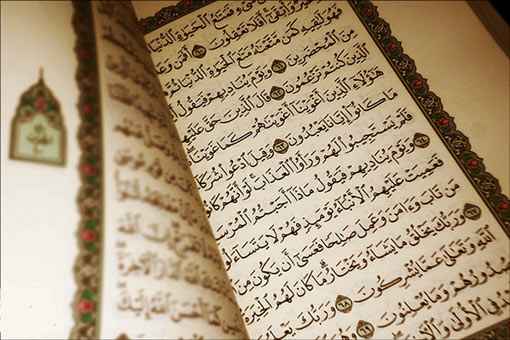
خاضت الفلسفة الإسلامية في تفسير عملية الخلق، خوضاً عقلياً، تكريماً منها لعقلانية الاتجاه، وتقديساً للعقل، على أسس توفيقية بين الاتجاه العقلي اليوناني وبين مفهوم الخلق كأساس يميز التصور الإسلامي، ولكن الذي غلب على التفسير النهائي لعملية الكون أنّها طمست مفهوم الخلق وشرحه على أصول الفهم الإسلامي الأصيل، من الكتاب والسنة. وكل ما أخذته من الإسلام هو التسليم بعنصر جديد في فهم علاقة الكون بالله وهو عنصر الخلق، ونقلها لمفهوم الملائكة في الإسلام إلى مفهوم العقول في الفلسفة اليونانية. والأمر جداً مختلف، بين التصور القرآني وبين التصور الفلسفي. ولذلك فيمكننا الحكم على هذا التفسير لعملية الخلق بأنّه بعد عن التصور القرآني بمقدار ما قرب من التصور الفلسفي:
1 ـ فالتفسير العقلي للخلق بنظرية الفيض، لا يعدو أن يكون خرافة أكثر منه حقيقة، بل إنّه خرافة وثنية تقوم على عبادة الأفلاك والنجوم التي كانت شائعة في العصور السحيقة وألبستها الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة ثوباً من المعقولية ولكنها لم تخرجها عن وثنيتها بل ضمت إليها وثناً جديداً زاد من وثنيتها اسمه العقل. وإلا فما هذه العقول التي تبدأ من الأول الفائض إلى العاشر الذي هو عقل فلك القمر؟ وما هذه العلاقة بين الكوكب الأخير وعقله بين المخلوقات في العالم الأرضي إيجاداً وتصريفاً؟ وبتعدد العقول وبشرح عملية الكون ماذا يبقى للتصور الديني القائم على أنّ الله هو خالق كل شيء وأنّه المتصرف في كل أمر وأنّ خلقه للأشياء إنما يكون بقوله لها (كن فيكون). فهذه النظرية تخل بمفهوم الخلق الإسلامي، لأنّها تجعل لغير الله ما يمكن أن يفهم منه أنّه يخلق، أو أقل ما فيها أنّها تجعل عملية الخلق صادرة بالضرورة عن الله صدور المعلول عن العلة وبلا اختيار ولا قصد ولا علم منه بالتفصيليات بينما يركز القرآن على العلاقة المباشرة في الخلق وأنّها عن إرادة واختيار كما قال تعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (يس/82). ذلك أنّ (الفاعل عبارة عمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار ومع العلم بالمراد) كما أنّها تجعل الخلق ليس إحداثاً بمعنى انفراج الشيء من العدم، وإنما الشيء موجود قديماً، وكل ما هنالك أنّه يخرج إلى الوجود بالفيض وعن طريق وسائط للإيجاد. وحقيقة الأمر أنّه لا واسطة بين الله ومخلوقاته في خلقه لها، وإلا لأدى ذلك إلى احتياج الله لغيره في خلقه للأشياء، وحاشاه من الاحتياج، فهو الغني الخالق لكل شيء. هذا فضلاً عن عدم انسجام هذه النظرية مع نفسها، إذ يمكننا أن نستفسر من أصحابها فنقول لهم: لماذا وقفت عملية الفيض عند العقل العاشر؟ أليس هذا تحكماً في عملية الفيض نفسها؟ أم إنّه التلبيس والاختباء وراء العقل في تبرير عبادة الكواكب؟ ثم إذا كانت العقول السماوية جميعها مفارقة فمن أين تولدت المادة؟ وكيف تصدر مادة عن عقل أو عن تعقل محض؟ وكيف يستقيم معنى الألوهية والأول لا يعلم بجزئيات الموجودات، ويترك ذلك للعقول بل لأدنى وأضعف العقول وهو العقل العاشر عقل فلك القمر ـ كما يقولون؟
2 ـ ثم إنّ مبدأ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ومن ثم فإنّ تفسير تكثر العالم لابد أن يكون عن طريق الوسائط، أو العقول عند الفيضيين. هذا المبدأ قائم على مفهوم خاطئ للواحد، إذ يرجع إلى تصور أفلوطين لواجب الوجود الأرسطي أو لمثال الخير الأفلاطوني بعد مزجه بالتصوف الشرقي، لينتهي بالقول بأنّ الواحد لا صفات له وهو فوق الفكر، والذي أخذه فلاسفة المسلمين أو مَن قاموا بعملية مماثلة للجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو، بضرب من العمل العقلي الذي يصور الجانب الإغريقي مشرحاً بكل ما يستلزمه من عناصر الشرح ومطبقاً على الله والذي يصور محاولة التوفيق بين هذا الجانب الإغريقي وبين الإسلام، فيما جاء به من صفات لله لتخرج بأنّ الواحد واحد بسيط لا يتكثر بوجه من الوجوه، ومن ثم تفسر كثرة العالم على طريقة الفيض كما ذكروها. وهذا التصور لله الواحد تصور مخالف تماماً عن تصور القرآن لله الواحد المتصف بصفاته التي منها الخالقية للأشياء من عدم وبلا واسطة، وبلا تحكم في مفهوم الألوهية بالمقاييس البشرية. ومن ثم فإنّ الواحد في نظر القرآن يخلق الكثير، ولا تتأثر وحدانيته بوجه من الوجوه. ولا ينفع فلاسفة المسلمين شيئاً أنّهم أضفوا على نظرية الأفلاك في الفلسفة اليونانية والمحركين الكثيرين عند أرسطو والمثل المفارقة عند أفلاطون، صبغة عقلية، أو سموها بالملائكة من أجل تقريب تلك الوثنيات إلى المفهوم الإسلامي، تفسيراً لعملية الخلق. ذلك أنّ الملائكة نفسها مخلوقات لله سبحانه وليست أسباباً ولا عللاً ولا يصح تسميتهم واعتبارهم عقولاً، وإنما هم عباد لله مكرمون ومسخرون (لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم/6).
3 ـ كما أنّ نظرية الخلق المباشر المستمر لا في زمن عند ابن رشد لم تكن إلا نمطاً عقلياً آخر، لتفسير عملية الخلق، فيه ردود الفعل لمذهب الفيض ولكنه لم يخرج عن التصور العقلي الفلسفي لشرح علاقة الكون بالله، بل كل ما فعله ابن رشد أنّه شرح العملية على مبادئ أرسطو بعيداً عن الأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة القائلتين بالوسائط. ومن ثم فهو يرفض التفريق بين الماهية والوجود. ولكن هذه التسوية بين الماهية والوجود أو بين العاقل والمعقول ليست حلاً لمشكلة الخلق. ومن ثم يلجأ إلى التفريق بين عالم الشهادة ـ الأراضي، الحسي ـ وبين عالم الغيب ـ عالم العقول ـ من أجل تفسير عملية الخلق، وتفسير صدور الكثرة عن الواحد وعلى قاعدة ارتباط المادة بالصورة وارتباط أجزاء العالم البسيطة مع بعضها وأنّ الوجود تابع للارتباط، ومعطى الارتباط هو معطى الوجود، وأنّ الخلق إخراج ما بالقوة إلى ما بالفعل. وأنّ الخلق يعود للسبب الرئيسي وهو العلم الإلهي الذي يخلق الموجودات ويربطها ببعضها بعلاقات السببية الثانوية ولا زمن لهذا الخلق، إذ هو الحفظ المستمر. وهذا المفهوم للخلق لا يفي بالغرض الإسلامي ذلك أنّ الخلق إيجاد من عدم وليس مجرد إخراج للشيء من القوة إلى الفعل والله سبحانه ليس بحاجة إلى مادة سابقة أو هيولى من أجل أن يخلق، وإذا ما رجعنا إلى أصول تفكير ابن رشد، نجد أنّه لم يخرج على فهم أستاذه أرسطو ونظرته للوجود بأنّه مركب من مادة وصورة هذا بالنسبة للعالم الأرضي أما عالم العقول أو العالم السماوي فمن الصورة وحدها وأنّ الصورة هي التي تجعل المادة موجودة بالفعل، بعد أن كانت موجودة بالقوة. كل ما هنالك أنّها كانت تخرج من القوة إلى الفعل بالمحركين الذين يرجعون إلى المحرك الذي لا يتحرك وهو واجب الوجود عند أرسطو، وأنّها أصبحت تخرج بفعل الملائكة التي هي أسباب ثانوية ترجع إلى الله كسبب رئيسي عند ابن رشد. فابن رشد وإن تخلص من الفيض التدريجي لتفسير عملية الخلق إلا أنّه لم يخرج عن التصور الفلسفي العقلي لها ذلك أنّ الخلق ليس إبداعاً وإخراجاً للشيء من العدم، وإنما هو إخراج ما بالقوة إلى الفعل. وأنّ الشيء قديم إذ المادة أزلية والصورة تعود إلى علم الله الأزلي والخلق ليس في زمن وبلا تفاوت، فالله بمجرد كونه خالقاً أو علة للوجود أو سبباً رئيسياً فهو يخرج ما بالقوة إلى الفعل، ومن ثم فالمادة التي تضم إليها الصورة القديمة.
ثم كيف تكون الأشياء حادثة وهي مخلوقة لا في زمان، وتصدر عن الله مباشرة صدور المعلول عن العلة، ذلك المبدأ الذي ارتضته الفلسفة الأرسطية والتي ينتمي إليها ابن رشد.
أليس مفهوم الخلق لا في زمن مخالفاً لصريح القرآن الذي أنزله الخالق سبحانه فالقرآن يثبت زمناً للخلق، فيقول عز وجل: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) (الأعراف/54).
وإذا فشلت الفلسفة الإسلامية في تفسير عملية الخلق وتجاوزت حدودها فقد فشلت إذن في تفسير المعرفة.
المصدر: نظرية المعرفة بين القرآن والسنة
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق