- ١٨ تموز/يوليو ٢٠٢٤ | ١١ محرم ١٤٤٦ هـ
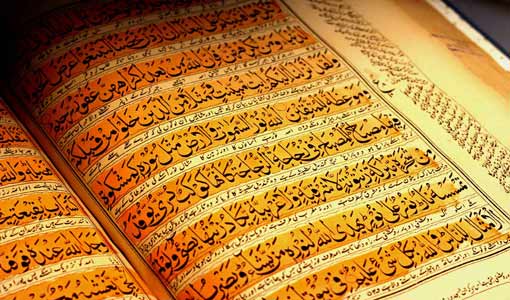
أروع صيغة لتحليل عناصر المجتمع وأدقها وأعقمها تضمنتها الآية الكريمة: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ) (البقرة/ 30).
هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية:
1- الإنسان.
2- الأرض أو الطبيعة على وجه عام، "إني جاعل في الأرض خليفة" فهناك أرض أو طبيعة على وجه عام، وهنالك الإنسان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى على الأرض.
3- العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالأرض وبالطبيعة، وتربط من ناحية أخرى الإنسان بأخيه الإنسان.
وهذه العلاقة المعنوية هي التي سمّاها القرآن الكريم بالاستخلاف.
حينما نلاحظ المجتمعات البشرية نجد أنها تشترك جميعاً في العنصر الأوّل والعنصر الثاني فلا يوجد مجتمع بدون إنسان يعيش مع أخيه الإنسان، ولا يوجد مجتمع بدون أرض أو طبيعة يمارس عليها دوره الاجتماعي.
أمّا العنصر الثالث ففي كلّ مجتمع علاقة كما ذكرنا، ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة وفي كيفية صياغتها. وهذا العنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر المجتمع. وكلّ مجتمع يبني هذه العلاقة بشكل قد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء الجتمع الآخر لها.
صيغتان للعلاقة:
العلاقة المذكورة في العنصر الثالث لها صيغتان:
الصيغة الرباعية.
الصيغة الثلاثية.
الصيغة الرباعية:
هي الصيغة التي طرحها القرآن الكريم للعلاقات الاجتماعية تحت اسم الاستخلاف وبموجبها ترتبط أربعة أطراف مع بعضها، ثلاثة منها داخل إطار المجتمع هي: الطبيعة، والإنسان مع الإنسان، وطرف رابع خارج عن إطار المجتمع، لكن هذه الصيغة تعتبر هذا الطرف الرابع مقوّماً من المقوّمات الأساسية للعلاقات الاجتماعية، وهو الله سبحانه وتعالى.
عند تحليل الاستخلاف نجده ذا أربعة أطراف لأنّه يفترض مستخلفاً (وهو الله تعالى) إلى جانب المستخلَف (وهو الإنسان وأخوه الإنسان) والمستخلَف عليه (وهو الأرض وما عليها).
هذه الصيغة الرباعية تنطبق مع وجهة نظر معينة نحو الكون والحياة تقول: إنّه لا سيّد ولا إله للكون والحياة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن دور الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان. وأيّة علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي في جوهرها علاقة أمين على أمانة استُؤمِنَ عليها، لا علاقة مالك بمملوك. وأيّة علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المركز الاجتماعي لهذا أو لذاك فهي علاقة استخلاف وتفاعل بقدر ما يكون هذا الإنسان مؤدياً لواجبه في هذه الخلافة، وليس علاقة سيادة أو ألوهية أو مالكية.
الصيغة الثلاثية:
هي الصيغة التي تربط بين الإنسان والإنسان والطبيعة، لكنها تقطع صلة هذه الأطراف بالطرف الرابع. وتجرّد تركيب العلاقة الاجتماعية عن البعد الرابع، عن الله سبحانه وتعالى وبهذا تتحول نظرة كلّ جزء إلى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وهذه الصيغة. وظهرت على مسرح التاريخ ألوان مختلفة للملكية والسيادة، وسيادةِ الإنسان على أخيه الإنسان بأشكالها المختلفة في إطار تعطيل البُعد الرابع وافتراض أنّ البداية هي الإنسان.
لو قارنا بين الصيغتين لاتضح أن إضافة الطرف الرابع للصيغة الرباعية ليست مجرد إضافة عددية، بل إنّ هذه الإضافة تُحدث تغييراً نوعيّاً في بُنية العلاقات الاجتماعية وفي تركيب الأطراف الثلاثة نفسها. ليس هذا مجرد عملية جمع ثلاثة زائد واحد، بل هذا الواحد الذي يضاف إلى الثلاثة سوف يعطي للثلاثة روحاً أخرى ومفهوماً آخر. سوف يُحدث تغييراً أساسيّاً في بُنية هذه العلاقات ذات الأطراف الأربعة كما رأينا، إذ يعود الإنسان مع أخيه الإنسان مجرد شركاء في محل هذه الأمانة والاستخلاف، وتعود الطبيعة بكل ما فيها من ثروات وبكل ما عليها ومن عليها مجرّد أمانة لابدّ من رعاية واجبها وأداء حقها. هذا الطرف الرابع هو في الحقيقة مغيّر نوعي لتركيب العلاقة.
القرآن الكريم إذن آمَنَ بالصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية. لكن القرآن الكريم ذهب إلى أكثر من هذا، فقد اعتبر هذه الصيغة الرباعية سُنّة مِنْ سُنن التاريخ، كما اعتبر الذين في الآية السابقة "فأقِمْ وجَهَكَ للدينِ..." سنة من سنن التاريخ.
وكيف اعتبر القرآن هذه العلاقة بصيغتها الرباعية سنة من التاريخ؟ الصيغة الرباعيّة عرضها القرآن الكريم على نحوين:
تارة عرضها بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور الله سبحانه وتعالى في العطاء، هذا العرض قرأناه في الآية: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً). هذه العلاقة الرباعية معروضة في هذا النص الشريف باعتبارها عطاءً وجَعْلا من الله. يمثل الدور الإيجابي التكريمي من رب العالمين.
وتارة عَرَضها من زاوية تقبّل الإنسان لهذه الخلافة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى:
(إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا) (الأحزاب/ 72).
الأمانةُ هي الوجه التقبلي للخلافة، والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة، الأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأ‘باء.
هذه الأمانة التي تقبّلها الإنسان وتحملها حينما عُرِضَت عليه بنصّ الآية الكريمة، أو بتعبير آخر. هذه العلاقة الاجتماعية بصيغتها الرباعيّة لم تُعرض على الإنسان على مستوى التكليف والطلب، وليس المقصود من تقبّل هذه الأمانة هو تقبّل هذه الخلافة على مستوى الامتثال والطاعة، والدليل على ذلك أنّ هذا العرض كان معروضاً على الجبال والسماوات والأرض أيضاً. ومن الواضح أنّه لا معنى لتكليف السماوات والجبال والأرض. من هذا نفهم أنّ العرض ليس عرضاً تشريعيّاً، بل إنّه يعني أنّ هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الوضع المنسجم معها بطبيعته، بفطرته، بتركيبه التاريخي والكوني.
الجبال لا تنسجم مع هذه الخلافة، والسماوات والأرض لا تنسجم مع هذه العلاقة الاجتماعية الربانية. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي كان مننسجماً مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة التي تُصبح أمانة وخلافة، بحكم تركيبه وبحكم بنيته وبحكم فطرة الله التي فطر الناس عليها.
العرضُ هنا إذن عرض تكويني، والقبول هنا قبول تكويني. وهذا هو معنى سنة التاريخ، أي أنّ هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة داخلة في تكوين الإنسان وفي مسار الإنسان الطبيعي والتاريخي.
في هذه الآية إشارة إلى أنّ هذه السنة التاريخية من الشكل الثالث، أي إنها سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان. وليست من تلك السنن التي لا تقبل التحدّي أبداً ولو للحظة، إنها سنة فطرة، ولكن هذه الفطرة تقبل التحدّي. القرآن أشار إلى هذا بقوله: (وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا)، وهذه العبارة تأكيد على أنها سنة تقبل التحدي على الرغم من أنها سنة من سنن التاريخ، وتأكيد على أنّها تقبل أن يقفَ الإنسان منها موقفاً سبيّاً، وهذا التعبير يوازي تعبير: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) في الآية السابقة:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا) (الرّوم/ 30).
الحقيقة أنّ الآية: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (الرّوم/ 30).
تؤكد بعبارة "الدين القيم" على أنّ هذا الدين هو الفطرة، وكلّ ما هو داخل في تكوين الإنسان وتركيبه ومسار تاريخه. أي أنّ يكون هذا الدين قيماً على الحياة، وأن يكون مهيمناً على الحياة. هذه القيمومة في الدين هي التعبير المجمل في هذه الآية عن العلاقة الاجتماعية الرباعية التي طُرحت في الآيتين: آية (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً) وآية (عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ). فالدين سنة للحياة والدين يُدخل في الحياة بعداً رابعاً لكي يُحدث تغييراً في كنه هذه العلاقة لا لكي تكون مجرد إضافة عددية.
المصدر: كتاب المجتمع والتاريخ (1-2)
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق